
لبنى الهاشمي
في زمن تتقاطع فيه الهويات وتتزاحم الانتماءات، تبرز العلاقة بين الدين والمواطنة كسؤال جوهري يلامس جوهر الوجود الإنساني في المجتمع. هناك محاضرة تستحق الإشادة والبناء عليها حيث تتناول "المواطنة والتفكير الديني: جدل التأصيل والتحديث | مؤتمر المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك" العلاقة الإشكالية بين مفهوم المواطنة في سياق الدولة الوطنية الحديثة والتفكير الديني الإسلامي المعاصر، مع التركيز على جدل التأصيل (المرجعية الدينية والتراثية) والتحديث (متطلبات الواقع المعاصر والتطورات الفكرية والحقوقية العالمية). تُعد الجلسة إسهاماً مهماً في تشخيص وإعادة صياغة العلاقة بين الدين والمواطنة في العالمين العربي والإسلامي. إن منهج التجاوز الديالكتيكي يمثل أداة منهجية فعّالة للخروج من ثنائيات الاستقطاب، وهو منهج مفيد لتحليل المفاهيم المتضادة، كالدين والعلم، أو الإيمان والحرية، أو الدين والمواطنة، إذ يُمكّننا من اكتشاف أرضية مشتركة أكثر نضجاً واتزاناً.. ولهذا كانت محاولة لتأسيس خطاب ديني يدمج بين الأصول الشرعية والمتطلبات الحديثة. كما أن التركيز على التمييز بين الحلول النظرية والتطبيق العملي (نماذج الإمارات، إيطاليا) يضفي بعداً واقعياً على النقاش.
المشاكل التي تم معالجتها:
- هيمنة الثنائيات الحادة: (التراث/الحداثة، الأصالة/المعاصرة، الدين/الدولة، المقدس/الدنيوي) التي تكبل العقل العربي.
- الجدل العقيم مقابل الديالكتيك المنتج: استمرار حالة المجادلة والمغالبة بدل التفاعل المنتج الذي يؤدي إلى مركب جديد.
- قصور المحاولات الإصلاحية السابقة: في التوفيق (محمد عبده)، التحديث الراديكالي (حسن حنفي)، أو التأصيل المنغلق (طه عبد الرحمن)، لعدم قدرة أي منها على معالجة الإشكالية جذرياً.
- تحدي الإسلام الحركي: آثار السلفية والإخوان المسلمين التي تستدعي نماذج تاريخية (كالخلافة) وتطرح فهماً للمواطنة ناقصاً أو تمييزياً.
- الجمود الفكري وصعوبة التجديد: تراجع قدرة العقل الإسلامي المعاصر على استيعاب الأفكار الحداثية والتعددية.
- إشكالية تطبيق المواطنة في التعددية: صعوبات القانون والممارسة في ضمان حقوق جميع المكونات الدينية والثقافية، سواء في العالم العربي أو في سرداب التعددية الغربية (نموذج المسلمين في إيطاليا).
- الخلط بين الدين والتراث الفقهي: عدم التمييز بين النصوص الإلهية (الوحي) والاجتهادات البشرية والتطبيقات التاريخية.
- سوء تقديم صورة الإسلام: التركيز على الجوانب الصراعية (الغزوات) في السيرة النبوية وإهمال القيم الإنسانية والأخلاقية.
- افتتح د. محمد الخشت بالتأكيد على استدعاء تجربة المدينة المنورة وعمر بن الخطاب نموذجاً لتجاوز الثنائيات، ثم قدم فكرة الانتقال من الجدل إلى الديالكتيك وصياغة “مركب جديد” مبني على الدولة الوطنية والعقل النقدي.
- أ. أحمد شلاطة عرَّف تحديات المواطنة الناشئة عن الفكر الحركي الإسلامي، مسلطاً الضوء على الجمود الفكري وفجوات تطبيقية في الدول العربية.
- د. عز الدين عنايت استعرض رأياً في “مرحلة ما بعد العلمانية”، داعياً إلى ترجمة التفكير الديني إلى لغة دنيوية مقبولة، مع تقديم نموذج المسلمين في إيطاليا كمثال للتعددية وتحديات الاعتراف القانوني والتعليم الديني.
- د. عبد الله الشريكة شدد على تمييز الإسلام كرسالة عن مسلك المنتسبين له، مستشهداً بحديث “يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله”.
- فضيلة مفتي الديار المصرية د. نظير عياد أبرز ضرورة العدالة والذكاء الفطري عند التعامل مع التراث (مقتبساً من ابن رشد والكندي)، والفصل بين النص الوحي والاجتهادات البشرية.
- اختتم د. الخشت بالتأكيد على التوافق الجوهري بين المتدخلين في فكرة المركب الجديد الذي يتجاوز ثنائية التراث والحداثة، ويُعيد بناء المرجعية على أسس إنسانية وتاريخية.
تبقى الخطوة التالية البحث التطبيقي في تصميم قوانين وتعليم ومنظومات تنظيمية تضمن مواطنة فعلية تشمل جميع المكونات دون تمييز، وتعزز قيم العدالة والعيش المشترك على أرض الواقع.
موقع "24"


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_0_0_0.jpg.webp?itok=K6qRVTbH)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A_14_0_0_0.jpg.webp?itok=g6wjl27s)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7_5_0.jpg.webp?itok=MW9x7ubB)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%B9%D8%B2_38_0_0.jpg.webp?itok=ZxzFfyrf)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A74_1.jpg.webp?itok=OGFtpwbI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_195_0.jpg.webp?itok=h7xIN7eA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A_0.jpg.webp?itok=0gQQHX2x)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_132_0_0.jpg.webp?itok=n7XQ1c0a)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/79-210122--_160ec75620a030_700x400.jpg.webp?itok=_5wpvA11)
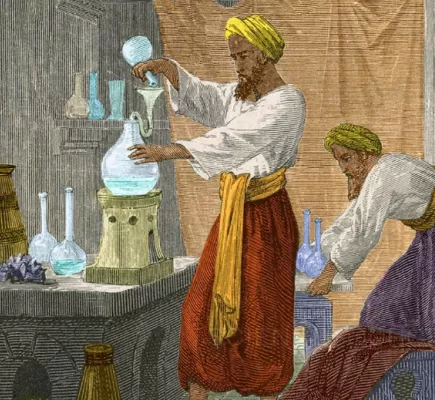
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%862_1_1.jpg.webp?itok=CeilKVHl)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/144291.jpg.webp?itok=l4H2M6dq)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9_15_0.jpg.webp?itok=hrRRCWz5)
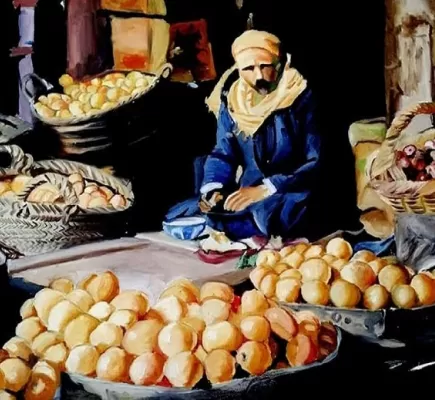
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0_0.jpg.webp?itok=MSxncSDF)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_104_4.jpg.webp?itok=RyHsGOvz)

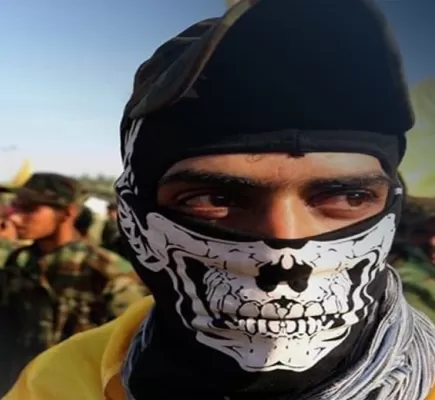


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_22_2_0.jpg.webp?itok=mAF6t0TM)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)
