
عام 1925؛ نشر العالم الأزهري والقاضي، علي عبد الرازق، كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، مع عنوان فرعي، هو: "بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام"، وهو مشروع نقد موجّه لوجود نظرية، أو تشريع، أو نظام خاص بالدولة في الإسلام.
أثار الكتاب الجدل والنقاشات، بل والمحاكمات، ولم يزل صداه يتردّد إلى اليوم، ولأنّ ذلك النمط من الكتب كثيراً ما يتم ذكره دون قراءته، سواء من قبل المؤيدين أو المعارضين، وهو ما يستدعي إعادة الاشتباك مع المضمون.
إنّ الخطوط العريضة لعمل عبد الرازق تتمثل في إنكاره للخلافة، ورفضه إضفاء القدسية عليها، باعتبارها مكوناً من مكونات عقيدة الإسلام، محاولاً البرهنة على كونها نتاجاً/ اختراعاً تاريخياً ودنيوياً خالصاً، وأنّ لا شأن لها بصحيح الدين، فلم تكن يوماً فرضاً إلهياً، ولا واجباً شرعياً. مقارِناً بين قيادة الرسول، صلى الله عليه وسلّم، وزعامة الملوك، ناقداً أدلة الفقهاء على الخلافة، وعلى وجود بناء واضح ومعتمد للدولة في الإسلام، فانتهى إلى التمييز بين الشريعة والسياسة، مُحدِداً وظيفة الأولى برعاية مصالح البشر الدينية، والثانية بجلب وحماية الأغراض والمصالح الدنيوية التي "جعل الله الناس أحراراً في تدبيرها"(1) ودفع المضار.
رسالة لا حكم
يجادل عبد الرازق بأنّه لا يوجد دليل واحد صريح، في الكتاب أو السنّة، يُقرّ بالخلافة، وأنّ مُشرّعيها اتخذوا سبيل القياس، فاستحدثوا مصدرين لسلطة الخليفة هما: سلطان الله تعالى؛ حيث الخليفة حامل الكافة/الناس على مقتضى النظر الشرعي. وسلطان الأمة؛ حيث يضمن منصبه "إظهار الشعائر الدينية، وصلاح الرعية"، وبالتالي اختلفوا حول ما إذا كان وجوب الخلافة عقلياً أم شرعياً؟ واختلفوا ومالوا أكثر إلى أحد دليلي الوجوب وهما:
1- إجماع الصحابة، رضي الله عنهم، والتابعين على تعيين خلفاء بعد وفاة النبي، صلى الله عليه وسلّم، ومبادرتهم لبيعة أبي بكر، رضي الله عنه، وأنه قد تمّ في كلّ عصر "تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبيّ، صلى الله عليه وسلّم، على امتناع خلو الوقت من إمام"(2).
اقرأ أيضاً: لماذا يُتهم علي عبدالرازق بتمهيد الطريق للإخوان المسلمين؟
2- من دون خليفة، فإنّه لا يمكن القيام بفرضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإظهار الشرائع الدينية؛ فالخليفة يحفظ الكليات الستّ: الدين والنفس والنسب والعقل والمال والعرض.
يرفض عبد الرازق الدليل الأول، وذلك بحجة استحالة حدوث الإجماع بتلك الصورة النموذجية التي اطمئن لها المُقرّون بحدوثه، فيقول: إنّه "لم يحدث في أيّ عصر أنّ الأمة بجملتها وتفصيلها اشتركت بالفعل في بيعة الإمام واعترفت بها".
يجادل عبد الرازق بأنّه لا يوجد دليل صريح في الكتاب أو السنّة يُقرّ بالخلافة وأنّ مُشرّعيها اتخذوا سبيل القياس
إنه يُسلِّم من حيث المبدأ بإمكان وجود خلافة على أساس البيعة الاختيارية من أهل الحلّ والعقد من المسلمين، والقائمة على رضاهم، لكنّ التاريخ في رأيه يثبت العكس، وهو أنّ "الخلافة في الإسلام لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة، وأنّ تلك القوة كانت، إلا في النادر، قوة مادية مسلحة"(3)، حتى وإن لم تكن ظاهرة الوجود بالشكل الكافي في حقبة ما، وذلك لانتفاء الحاجة لاستعمالها، فإنّ المُلك عامة يقوم على القوة، وذلك لأنه يعني السلطة المطلقة، والتي تبلغ المنافسة عليها دوماً الحدّ الذي لا يمكن معه حسمها إلا لصالح الفئة الغالبة غلبة عسكرية، القادرة على إخضاع الآخرين بالقوة، ولا فرق هنا بين أن يكون الواقع التي سَتقرّه وتشكله تلك الفئة "جارياً على نواميس العقل أم لا، وموافقاً لأحكام الدين أم لا"، فالعامل المشترك إذاً هو الغلب والقهر، وما "الملك إلا التغلب والحكم بالقهر" كما يقول ابن خلدون(4)، ويوافقه عبد الرازق في ذلك.
وإذا كانت الخلافة تعني لدى مُقريّها وراثة النبي، صلّى الله عليه وسلّم، في رياسته الدينية والدنيوية، أي في حكمه بين المسلمين؛ فإنّ حكم النبي، صلى الله عليه وسلّم، لم يكن تغلباً أو قهراً، ولا مُلكاً، أو زعامة سياسية، وإنما هو زعامة النبوة، التي يميزها عبد الرازق عن زعامة المُلْك، فعلى الرغم من أنّ كليهما يتضمنان القوة ونفاذ الرأي والطاعة، إلا أنّ الأولى تمتاز بكونها "تقتضي لصاحبها حقّ الاتصال بكلّ نفس اتصال رعاية وتدبير"، في مقابل زعامة الملك التي هي تصريف مختص بالشؤون الدنيوية، وتصريف الأحوال العامة، ولا شأن لها ببواطن النفس؛ إنه حكم، يُقرّ عبد الرازق بذلك، لكنّه ليس حكم سلطان، ولكنّ حكم نبي مصطفى من الله بتلك القوة، وذلك الكمال الحسي والروحاني والنفسي الذي يؤهله-وحده- لزعامة، وسيادة، وهيبة تملأ القلوب والأنفس، وبالتالي تضمن "حقّ التصريف لكلّ قلب تصريفاً غير محدود"(5) .
اقرأ أيضاً: محاكمة الأزهر للشيخ علي عبدالرازق.. كيف تمّت؟
من العبث إذاً الحديث عن نبيّ دون الحد الأدنى من الزعامة في قومه، أو بين أتباعه؛ لأنّه لا نبوة من دون أتباع، ولا دين من دون طاعة، لكن لا ينبغي مطابقتها بزعامة المَلِك، إنّ ولاية النبي، عليه السلام، على قومه ولاية روحية، ومنبعها إيمان قلب الفرد، على عكس ولاية الحاكم أو الملك المادية، التي تعتمد القوة و"إخضاع الجسم" في المقام الأول وسيلة لها، إنّ ولاية النبي، عليه السلام، هي "إرشاد إلى الله"، بينما ولاية الحاكم "تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض" (6)، الأولى لله تعالى، والثانية للناس -على اختلافاتهم.

لقد كان القرآن الكريم صريحاً في أنّ حقّ النبي، عليه السلام، على أمته لم يكن "غير حقّ الرسالة"، إنّه يفصل بين مهام الأخيرة، ومهام الحكم؛ لأنّه يمنع النبي من حقّ إكراه الناس على الإيمان بصفته مُوكَلاً بضمان ذلك، أو مسؤولاً "حفيظاً" عنه؛ فهو ليس بحامل الناس على أن يتبعوا دعوته بالقوة، وبالطريقة التي يحمل بها الملوك دعواتهم على الناس، كعبيد عندهم أو ممتلكاً من ممتلكاتهم، فيما لم يستعبد النبي، صلى الله عليه وسلّم، أو يمتلك رقاب الناس، وذلك بنصّ القرآن الكريم نفسه، وبالتالي؛ فإنّ "من لم يكن حفيظاً ولا مُسيطِراً ليس بملك، لأنّ من لوازم الملك السيطرة العامة والجبروت، وسلطاناً غير محدود"(7).
من ثمّ، فإنّ ادعاء سلطة سياسية للخليفة مستمدة من الرسول، عليه السلام، وظيفتها حفظ الكليات الستّ؛ هو ادعاء باطل، حتى ولو ثبت عن الرسول، عليه السلام، ممارسة أمور الحكم والسياسة، فإنّه قد مارسها لتوفير القاعدة الثابتة من الحرية والمساحة الملائمة لنشر الدعوة، فإذا ما توافرت تلك الشروط بشكل مُسبَق، لم تعد به حاجة إلى الحكم. إنّ كلّ عمل حكومي أو مظهر للملك والدولة في سيرة الرسول "لم يكن سوى وسيلة من الوسائل التي كان عليه أن يلجأ إليها لتثبيت الدين وتأييد الدعوة" في بداياتها، وفق تقاليد ذلك العصر الذي ظهر فيه الإسلام، وذلك لضمان ألا يزول.
أثار الكتاب الجدل والمحاكمات ولم يزل صداه يتردّد إلى اليوم دون قراءته من قبل كثير من المؤيدين أو المعارضين
ذلك ما كان للنبي، عليه السلام، من زعامة، وحكم مشروط بصفته نبياً ورسولاً، وهي وظيفة لا شريك له فيها من الناس تتمثل في "رعاية الظاهر والباطن، وتدبير أمور الجسم والروح"(8)، ويرتبط بخصوصية تلك الوظيفة ما أقرّه الإسلام من "عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات" كان على النبي إقرارها في قومه، والتي تظلّ "شرعاً دينياً خالصاً لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير، وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا، وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا، فذلك مما لا ينظر الشرع السماوي إليه"(9).
إنّ الحكم والقضاء ومراكز الدولة هي "خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها، ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى إحكام العقل، وتجارب الأمم"(10).
هكذا نقد عبد الرازق الدليل الثاني، فقد ترك الله للبشر إدارة شؤونهم الدنيوية والاجتماعية، وفق ما توصلوا إليه عبر التجربة، وما اكتسبوه من خبرة وحكمة أخلاقية تحفظ مقاصد الشريعة، دون أن تؤول من وسائلها القديمة ما يُعطّل المقاصد ذاتها.
أما إذا كانت إقامة شعائر الإسلام، وحفظ عقيدته، في حاجة إلى مؤسسة سياسية تحميهما، فإنّ التاريخ يبرهن على العكس، فعند ابن خلدون مثلاً؛ الخلافة المثالية التي يتحدث عنها الفقهاء، وكما يقدّرها ويبجلها ابن خلدون نفسه، قد انتهت منذ عصر هارون الرشيد وبعض أولاده، لتتحول بعد ذلك إلى مُلك بحت، كما هو في ملوك العجم بالمشرق، ليس فيه من حكم النبي شيء، وقد حدث ذلك دون أن يهز من دعائم الإسلام، وأنه لما كانت الخلافة تتداعى في بغداد، وأراضي المسلمين مقسمة إلى دول شبه مستقلة، أو مستقلة بالكامل عنها، فقد استمرت شعائر وأركان الدين رغم ذلك، فإن كان الدين نفسه ليس في حاجة إلى "تلك الأصنام" التي يدعونها خلفاء(11)، كما أنّ الله تعالى "لا يريد لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة، ولا تحت رحمة الخلفاء"، وإنما نابع من أنفسهم(12)، فكيف للشؤون الدنيوية التي هي محلّ تدبير وتنظيم عملي وواقعي، أن تكون في حاجة إلى الخلافة؟
لقد اكتمل الدين في حياة النبي، عليه السلام، فإذا كان قد أنشأ دولة سياسية بالفعل، فما كان يمنعه من بيان أمرها بوضوح تحقيقاً لذلك الكمال، من دون أن يترك أمرها غامضاً ومبهماً، تاركاً أصحابه وأتباعه في حيرة، وتناحر، حتى قبل أن يتم دفنه؛ فيصلون لاحقاً إلى حدّ الصراع المسلح، وإذا حدث العكس، أي أنّ النبي، عليه السلام، قد أقر نظاماً سياسياً واضح المعالم بالفعل، وذا حصانة مقدسة بقداسة الرسالة نفسها، فلماذا اختلف أوائل أصحابه وأتباعه في ذلك النظام الجلي الواضح؟
الخلافة المثالية التي يتحدث عنها الفقهاء بنظر ابن خلدون انتهت منذ عصر هارون الرشيد وبعض أولاده
يُبرِز عبد الرازق ذلك الغموض والإبهام المتعلق بالدولة في حياة النبي، عليه السلام، عبر حجتين تاريخيتين:
أولًا: الأخبار الواردة عن تولية النبي قضاة (عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، رضي الله عنهم)، أو عمالاً على الأموال، أو حرّاساً على الأراضي، تلك الأخبار ليست بالقوة أو الاطراد الذي يُرجّح كفة نزعة ذات طابع سياسي متماسك ومتعمد، من أجل التنظيم السياسي لدولة، وأنّه لم يكن في تلك التعيينات "شيء مطرد، وإنما كان يحصل لوقت محدود"، وأنّ ذلك النوع من "أعمال الحكومات ووظائفها الأساسية لم يكن في أيام الرسالة موجوداً على وجه واضح لا لبس فيه"(13)، كما يطول ذلك اللبس ما هو مثبت من تعيين النبي للقضاة، فقد اختلف الرواة مثلاً في تعيين علي، رضي الله عنه، على اليمن، فقال بعضهم إنّه عُيّن للقضاء، وقال آخرون إنّه عُيّن لقبض الزكاة، أما معاذ بن جبل، رضي الله عنه، فقد قيل إنّه عُيّن على اليمن "قاضياً في رأي، وغازياً في رأي، ومعلماً في رأي"(14).
ثانياً: إنّ ترجمات المؤلفين عن الخلفاء كانت متماسكة ومتكاملة فيما يخصّ بيان وحصر عمالهم، وولاتهم، وقضاتهم، وغير ذلك من المسؤولين السياسيين والعسكريين عن الأقطار المختلفة، أما فيما يخصّ النبي، صلّى الله عليه وسلّم، يظلّ ذلك المبحث ضعيفاً، و"مبعثراً غير متسق" لدى المؤلفين أنفسهم، وأن نسقهم فيه لا يتفق مع طريقة بحثهم في بقية العصور(15).
كما يستدل عبد الرازق على ذلك الإبهام، من كلام عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عقب حادثة السقيفة، حين خطب اعتذاراً من إنكاره خبر وفاة النبي، عليه السلام، في حينه، وقال: "لكنّني كنت أرى رسول الله سيدبّر أمرنا حتى يكون آخرنا"، إذًا؛ فقد كانت وفاة النبي، عليه السلام، وعدم بقائه حتى يتم تدبير أمور المسلمين، أحد مكونات صدمة عمر، رضي الله عنه، الذي كان مطمئناً لبقاء النبي، عليه السلام، فلم ينتظر وصية بخصوص الحكم، لم يضعها النبي بدوره.
إعادة اختراع المساوئ
أما عن الأحاديث التي يستند لها مؤيدو الخلافة، والتي تظهر دعوة النبي، عليه السلام، لحفظ البيعة وطاعة الإمام، فإنه بعيداً عن الخوض في صحّتها من عدمها، يصفها عبد الرازق بأنّها وليدة زمانها وبيئتها؛ حيث المجتمع القبلي ما يزال حاضراً بقوة، وبالتالي فإنها دعوة لاحترام السنن والتقاليد السياسية للقبائل العربية (ما عدا تلك التي تخالف الإسلام)، وبأنها تشبه دعوة المسيح لاحترام السلطة السياسية القائمة في زمانه، وأنّ دعوة النبي، عليه السلام، تلك لا توجب بأيّ حال اختراع الشرط نفسه الذي تُحيل إليه، ممثلًا في البيعة والإمام، بالطريقة نفسها التي لا يُوجِب فيها أمره بإكرام السائلين والفقراء اختراع فقراء ومساكين، بدلاً من استئصال شروط الفقر، وقد تحدث الرسول، صلّى الله عليه وسلّم، في شؤون الرقّ، فهل قصد بحديثه ذلك الإقرار به والرغبة فيه؟ كما أنّ القرآن الكريم يضبط ما يخصّ الطلاق والاستدانة والبيع والرهن وغيرها من الأحكام، لكن ذلك ليس دليلاً على وجوب شيء منها في الدين، أو أنّ لها عند الله شأناً خاصاً(16).
إنّ من المعقول عند عبد الرازق أن يدين العالم أو جزء منه بدين واحد، لكن ليس بحكومة واحدة، إنّ ذلك ليس من الطبيعة البشرية، ولم يقرّه القرآن الكريم كذلك؛ فقد "ترك الله الناس أحراراً في تدبير أحوالهم الدنيوية، على ما تهديه إليه مصالحهم، وأهواؤهم، ونزعاتهم، حكمة لله في ذلك بالغة ليبقي الناس مختلفين"، وليتحقق التدافع بين الأمم، الذي من شأنه إتمام العمران(17)، والخلافة هي التي صادرت ذلك الحقّ من الناس؛ حيث كانت سبباً في انحدار علوم السياسة لدى المسلمين، حتى في ظلّ النهضة المعرفية الضخمة في فروع العلوم الأخرى، وذلك بسبب عدائها للبحث في السياسة، وذلك لخطورة ذلك البحث؛ لأنّه يكشف خصائص وأنواع الحكم، فيجعلها موضوعاً للدراسة والنقد، وكذلك للقبول والرفض، على أسس واقعية.
دين لا دولة، ودولة لا دين
لقد بنى العرب دولتهم، بلا شكّ، على أساس وحدتهم الدينية، لكن الجدالات والصراعات التي أنجبت تلك الدولة، كانت بالأساس سياسية، كما أنّها احتكمت، في المقام الأول، إلى القوة والسيف، كما كانت تفعل حكومات كلّ الأمم في ذلك الوقت.
لا ينكر عبد الرازق دور تلك الدولة في "تحول الإسلام وتطوره"(18)، لكنّها ظلت في رأيه "دولة عربية، أيدت سلطان العرب، وروّجت مصالح العرب" كأمة ناهضة فاتحة، وقد أدرك رجال السقيفة تلك المصالح بوضوح، وقد دار جدالهم على من هو الأقدر على ضمانها، لقد كان جدالاً حول "حكومة مدنية دنيوية"(19)، ونزاعاً في "ملوكية ملك، لا في قواعد دين، ولا في أصول إيمان"(20)، وبالتالي تواجدت المعارضة منذ اليوم الأول، وهو الدليل على أنّ المسلمين في تعاملهم مع الخلافة استحلوا "الخلاف لها، وهم يعلمون أنّهم إنما يختلفون في أمر من أمور الدنيا، لا من أمور الدين، وأنهم إنما يتنازعون في شأن سياسي، لا يمسّ دينهم، ولا يزعزع إيمانهم"(21).
لم تكن القوة وحدها عامل الحسم في حالة أبي بكر، رضي الله عنه، بقدر ما كانت مكانته السامية كأقرب صحابة الرسول، عليه السلام، وسابقته في الإسلام، ما خلق حوله نوعاً من التوافق، غير التام، بل المُهدّد بالزوال في بعض الأحيان، حيث لم يُمتنع وجود تململ، ومعارضة عبرت عنها صراحة "الردة"، ففي رأي عبد الرازق: "نشأ لقب مرتدين لمرتدين حقيقيين عن الإسلام، ثم بقي لقباً لكلّ من حاربهم أبو بكر بعد ذلك، سواء كانوا خصوماً دينيين ومرتدين حقيقيين، أم كانوا خصوماً سياسيين غير مرتدين"(22).
بنى العرب دولتهم على أساس وحدتهم الدينية لكن الجدالات والصراعات التي أنجبت تلك الدولة كانت بالأساس سياسية
بالتالي؛ فقد تمّ ردعهم بالقوة، وقد "كان فيهم من بقي على إسلامه، لكنه رفض أن ينضم إلى وحدة أبي بكر، لسبب ما، من غير أن يرى في ذلك حرجاً عليه، ولا غضاضة في دينه، وما كان هؤلاء، بلا شكّ، مرتدين، وما كانت محاربتهم لتكون باسم الدين، فإن كان لا بدّ من حربهم فإنما هي السياسة، والدفاع عن وحدة العرب، والذود عن دولتهم".
لقد كان تسليم قبائل الجزيرة العربية القيادة لأبي بكر، رضي الله عنه، حدثاً ذا طابع سياسي، بما تضمنه من معارضة، تمثلت في رفض أداء الزكاة، والذي لا يُعد بالضرورة رفضاً للدين، وإنما كان بالنسبة لمعارضي أبي بكر "بديهياً أن يمنعوا الزكاة عنه؛ لأنّهم لا يعترفون به، ولا يخضعون لسلطانه وحكومته"(23)، لاعتبارات قبلية، أو سياسية بشكل عام، رغم ذلك فقد أقرت جماعة من المسلمين لأبي بكر مقاماً دينياً، وانقادوا إلى سياسته على هذا الأساس، ذلك المقام ما كان ينبغي لأحد حيازته دون الرسول، والذي كان نابعاً من "سلطانه الواسع على القلوب والعقول"، ولأنّ القبائل اتبعت الرسول بصفتهم مؤمنين يتبعون نبيهم، وليس كرعية تتبع حاكمها، وبالتالي؛ فإنّ التبعية السياسية القائمة على الإيمان لا تجوز لغير الرسول، صلى الله عليه وسلّم؛ لأنّه تميّز لا شريك له فيها من الناس، وهي "رعاية الظاهر والباطن، وتدبير أمور الجسم والروح"(24).
اتصفت صراعات وحروب ما بعد النبي بالغلاف الديني رغم طبيعتها الدنيوية/السياسية، إضافة إلى استحداث لقب الخليفة، فكانت تلك أسباب الخطأ "الذي تسرب إلى عامة المسلمين، فخيل إليهم أنّ الخلافة مركز ديني، وأنّ من وُلِّي أمر المسلمين، فقد حلّ منهم في المقام الذي كان يحله رسول الله، صلى الله عليه وسلم"(25)، فكانت حجة للملوك والسلاطين، ليستذلوا رقاب الناس، ويلصقوا مكانتهم بمكانة لا تجوز لهم، ولا يدنون منها بشيء، وادّعى منهم لنفسه أنّه ظلّ الله على الأرض، فجعلوا الخلافة جزءاً من العقيدة، وصنماً ينفي عن السياسة صفاتها من التحديث والتجريب، فإنّ شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة، يسميه الفقهاء خلافة، ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء، والواقع أيضاً؛ أنّ صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك، فليس بنا حاجة إلى تلك الخلافة لأمور دنيانا" .
هوامش:
1- الإسلام وأصول الحكم، ص 125.
2 - كتاب المواقف.
3 - الإسلام وأصول الحكم، ص 35.
4 - مقدمة ابن خلدون، ص 132.
5 - المصدر السابق، ص 80.
6 - الإسلام وأصول الحكم، ص 82.
7 - المصدر السابق، ص 85.
8 - من مذكرة عبد الرازق التي ردّ فيها على ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر.
9- المصدر السابق.
10 - الإسلام وأصول الحكم، ص 121.
11 - المصدر السابق، ص 47.
12 - المصدر السابق، ص 48.
13 - المصدر السابق، ص 57.
14 - المصدر السابق، ص 56.
15 - المصدر السابق، ص 58.
16 - الإسلام وأصول الحكم، ص 28.
17 - المصدر السابق، ص 91.
18 - المصدر السابق، ص 109.
19 - المصدر السابق، ص 110.
20 - المصدر السابق، ص 116.
21 - المصدر السابق، ص 111.
22 - المصدر السابق، ص 118.
23 - المصدر السابق، ص 115.
24 - من مذكرة عبد الرازق التي ردّ فيها على ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر.
25 - الإسلام وأُصول الحكم، ص 119.

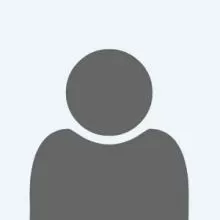

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_89.jpg.webp?itok=1bbg4H68)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_21.jpg.webp?itok=DT9pZt2S)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_4.jpg.webp?itok=PHrWu2g2)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_111.jpg.webp?itok=nFJhtK9g)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_164.jpg.webp?itok=eqJuYvo4)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_134.jpg.webp?itok=BE_JxJEu)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_155.jpg.webp?itok=P4v7Bo2w)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_77.jpg.webp?itok=H_vYf3MZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_19.jpg.webp?itok=ZDRGFp_T)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_46.jpg.webp?itok=ADVws-oi)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%862.jpg.webp?itok=ua0Vs-kv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_124.jpg.webp?itok=Y78iNwRY)




![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_100.jpg.webp?itok=nCnMcQEz)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84_14.jpg.webp?itok=1i6EBzVc)






![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_20.jpg.webp?itok=y4loNQqm)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D8%B2%D8%A92_6.jpg.webp?itok=uVZ_6OYE)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_203.jpg.webp?itok=T_t3iyVS)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_86.jpg.webp?itok=Y0l9-L-5)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D8%A7_4_0_6_1.jpg.webp?itok=UC_8bFmi)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_19_2_0.jpg.webp?itok=dY0K1834)