
مع وصول البطريرك يوحنا العاشر اليازجي إلى سدّة القيادة في فترة حساسة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، برز تحالف الكنيسة مع النظام بشكل واضح، حيث اتخذت موقفًا بات يُنظر إليه على أنّه مُحابٍ للسلطة مقابل حماية المؤسسات الكنسية وأمن المسيحيين. هذا الموقف وضع الكنيسة في مأزق مع جمهورها الذي كان يتوق إلى الحرية والكرامة، فبدل أن تكون صوتًا معبّرًا عن آمال أبناء الرعية، وجدت نفسها منقسمة بين الولاء للنظام والتزامها الروحي تجاه شعبها.
الكنيسة بين البقاء والخوف
رغم أنّ النظام السوري كان يروّج لنفسه كحامي للأقليّات، وخصوصًا المسيحيين، إلا أنّ الأرقام والواقع على الأرض تشير إلى خلاف ذلك. فقد تراجع عدد المسيحيين في سوريا من حوالي مليوني نسمة قبل اندلاع الثورة عام 2011 إلى أقل من نصف مليون نسمة تقريبًا اليوم. ويعود هذا التراجع الحاد إلى عوامل متعددة تشمل النزوح القسري، والتهجير، والهجرة، بالإضافة إلى القتل والتعذيب في السجون التي صاحبت الصراع السوري. ويعكس هذا الواقع هشاشة وضع المسيحيين في سوريا، وعدم قدرة الكنيسة على حمايتهم والحفاظ على تماسكهم في مواجهة الأزمة المستمرة.
مع مرور الوقت، أظهرت الأحداث أنّ هذا التحالف لم يصبّ في مصلحة الكنيسة وشعبها، بل عمّق الفجوة بين القيادات الدينية وأبناء الرعية، وأدى إلى حالة من الإحباط والشكوى بسبب غياب التمثيل الحقيقي لطموحات المسيحيين في سوريا. أصبحت الكنيسة بذلك ليست مجرد مؤسسة دينية، بل أصبحت لاعبًا سياسيًا يتحمّل عبء التوازنات الصعبة بين البقاء ضمن دائرة السلطة أو فقدان الشرعية الشعبية.
ولم يقتصر الأمر على الصمت إزاء الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال الثورة، بل تجاوزه أحيانًا إلى تبريرها أو التشكيك بوجودها من الأصل. فقد عبّر المطران يوحنا جهاد بطاح في مقابلته الأخيرة عن موقف مثير للجدل، حين اعتبر أنّ النظام لم يكن على علم بما يجري في سجونه، وأنّ الرئيس الفار بشار الأسد هو ضحية مؤامرة. هذا الخطاب يعيد إنتاج السردية الرسمية التي أسقطها التاريخ، ويكشف في الوقت ذاته عن العجز البنيوي للكنيسة عن ممارسة النقد الذاتي اللّازم للإصلاح.
حركة التغيير الأنطاكي: صوت من داخل الكنيسة
في هذا السياق، برزت "حركة التغيير الأنطاكي" التي أصدرت بيانها الأوّل في 7 كانون الثاني (يناير) من هذا العام، مطالبةً بتنحّي البطريرك يوحنّا العاشر (يازجي)، بسبب "عمق ارتباطه بالنظام السوري"، وبسبب انحياز الكنيسة للسلطة على حساب المظلومين. ولعلّ أهمية هذه الحركة لا تكمن في أعداد الموقعين عليها فحسب، بل في الجرأة اللّاهوتية والسياسية التي عبّرت عنها، وفي محاولة كسر صمت طويل داخل المؤسسة الكنسية.
أكّد البيان الثاني الصادر عن حركة التغيير الأنطاكي، الذي تلاه الناطق باسمها د. وديد سلبود، أنّ الإصلاح البنيوي في الكنيسة لا يمكن أن يبدأ من الشعارات أو التصريحات، بل من معالجة جذور الخلل، وفي مقدّمها آلية انتخاب البطريرك، التي ما زالت محكومة بعقلية مغلقة تحتكر القرار، وتُقصي المشاركة الشعبية بعيدة عن مفهوم التمثيل الجماعي. ولهذا دعا البيان إلى تشكيل لجنة مستقلة للحوار مع ممثلّي الحركة، بهدف فتح نقاش مؤسّسي حول مستقبل الكنيسة.
ومع ذلك، تصطدم الحركة، بحسب ما يذكر مؤسسوها، بالرغم من اتساع قاعدتها وتنامي الوعي بين الإكليروس والعلمانيين/ات"، بجدران صلبة داخل البنية الكنسية ذاتها. فغياب الأطر القانونية للمساءلة أو التغيير، وخصوصًا نتيجة تعطيل مجالس الأبرشيات أو تهميش أدوارها، جعل من البطريرك والمطارنة سلطات مطلقة شبه وراثية. إذ لا تفرض عليهم المحاسبة من قاعدة المؤمنين، ولا يُسألون أمام هيئة مستقلة؛ ممّا أنتج علاقة رأسية مغلقة بين الراعي والرعية. وقد تجذّر هذا النمط السلطوي عبر قرون من التقاليد الكنسية التي مزجت بين الإكليروس والسلطة الزمنية، فحوّلت بعض المناصب الكهنوتية إلى مواقع نفوذ أبويّ لا تخضع لأيّ ضوابط مؤسساتية.
كما أنّ هذا الانغلاق البنيوي لا يُعدّ مجرّد خلل في الإدارة أو التنظيم، بل يعكس أزمة عميقة في فهم دور الكنيسة كمؤسسة حيّة تستمد شرعيتها من تفاعلها مع الناس، لا من تحالفها مع السلطة السياسية أو من استمرارها في نمط سلطوي هرمي يرفض المساءلة. من هنا، فإنّ إصلاح آلية انتخاب بطريرك أو مطران ليس مجرّد مطلب إداري، بل هو مدخل لتفكيك منظومة كاملة من الجمود، ولبناء كنيسة أكثر انسجامًا مع قيم الشفافية والمشاركة.
النساء... نصف الكنيسة المستبعد
الكتابة ليست حكرًا على جنس أو نوع محدد، بل هي حق لكلّ من يمتلك رؤية ورغبة في التعبير عن أفكاره. وكوني فتاة، يضيف وجودي بُعدًا مختلفًا وضروريًا للنقاش، خاصّة عندما نتناول قضايا المجتمع والكنيسة، حيث يُهمّش صوت النساء عمومًا، واللّاهوتيات خصوصًا، أو يُسكت غالبًا. لذلك، أعتبر كتابتي فرصة لإيصال صوت جديد ومهم في هذا الحوار.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن الحديث عن غياب الإصلاح في الكنيسة الأنطاكيّة دون التوقف عند أحد أكثر أوجه التهميش وضوحًا: تهميش المرأة. فالنساء يشكّلن عماد الحضور الكنسي والخدمة الاجتماعية والروحية، لكنّهنّ غائبات تمامًا عن مواقع القرار. هذه المسألة ليست مجرد إقصاء سياسي أو كنسي، بل هي تعبير عن بنية لاهوتيّة ذكوريّة ترفض الاعتراف بالمرأة كمؤهلة للقيادة، رغم وجود أصوات لاهوتيّة معاصرة تطالب بإصلاح جذري في النظرة الكنسيّة إلى المرأة، وتشير إليها باعتبارها "أكبر قضية مُتجاهلة في الكنيسة".
إنّ استبعاد النساء من العمل الإداري واللّاهوتي والرعائي لا يمثل غبنًا في العدالة فحسب، بل يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام أيّ مشروع إصلاحي. فكيف يمكن لكنيسة تُقصي نصف جسدها أن تبني جسدًا صحيًا كاملاً وقويًا؟
أزمة الشرعية والانفصال عن الناس
من بين أخطر ملامح الأزمة التي تعيشها الكنيسة الأنطاكية، هي فقدانها التدريجي للشرعية أمام أبنائها. لم يعد الناس يشعرون أنّ القيادات الكنسية تمثّلهم أو تعبّر عن وجعهم، بل أصبحت القيادة الكنسية مجرّد جهاز منفصل، يستمدّ شرعيته من الحاكم السياسي لا من المؤمنين.
وقد أدّت الإكليروسيّة المفرطة، والتمسك بالتقليد بوصفه سلطة جامدة لا حيّة، إلى انغلاق المؤسسة على ذاتها. ولم تسعَ إلى تحديث أدواتها الفكرية أو الإدارية، وهو ما أدّى إلى غربة متزايدة بين "الرعاة" و"الرعيّة"، الأمر الذي يفسّر ظهور مبادرات مثل حركة التغيير، كمحاولة لاستعادة صوت الناس من قلب المؤسسة.
الكنيسة بين ذمّيّة مستعادة وشراكة مفقودة
وفي غياب شرعيّة جديدة بعد سقوط النظام البائد السوري، تسعى بعض القيادات الكنسية إلى بناء علاقة جديدة مع السلطة، هذه المرّة مع حكّام ما بعد الأسد، القادمين غالبًا من خلفيات إسلامية سياسية. وهنا تعود إلى الواجهة نماذج من التاريخ مثل "نظام أهل الذّمة"، إذ تُقدّم الكنيسة نفسها كـ "ممثّلة للمكوّن المسيحي"، لا كشريك وطني، بل كـ "جسم جماعي" يجب التفاوض معه عبر بطاركة ومطارنة.
هذا النموذج يُعيد إنتاج منطق الملل العثماني، حيث لا وجود للمواطن الفرد، بل للطائفة المحكومة عبر شيخها أو بطريركها. إنّه نموذج معادٍ للحداثة، ويشكّل عائقًا أمام قيام دولة مدنية تكون الكنيسة فيها فاعلًا روحيًّا حرًّا، لا ذراعًا للسّلطة، ولا أداةً للحماية من اضطهاد متخيّل.
أزمة القيادة في الكنيسة الأنطاكية: بين الفشل الإداري وغياب الرؤية
تشهد الكنيسة الأنطاكيّة اليوم واحدة من أخطر أزماتها القيادية في تاريخها الحديث. فبينما يُنتظر من القادة الكنسيّين أن يكونوا نموذجًا روحيًا وإداريًا يُلهِم المجتمع المسيحي ويقوده نحو التغيير والإصلاح، فإنّ الواقع مغاير تمامًا لهذه التوقعات. تعاني القيادة الإكليريكيّة من فشل إداري واضح وضعف في الرؤية، فضلًا عن هيمنة مراكز السلطة على صنع القرار بعيدًا عن مشاركة حقيقية وشفافة.
هذا الواقع المتردّي لا يقتصر على داخل الأبرشيات في سوريا ولبنان فقط، بل يمتد إلى جاليات الشتات التي تشعر بالاغتراب نتيجة المركزية المفرطة التي تهمّش دورها وتُفرغ وجودها من أيّ تأثير حقيقي في صنع القرار. فغالبًا ما تُتخذ القرارات في المركز البطريركيّ في دمشق أو البلمند دون إشراك فعليّ لأبناء المهجر، رغم امتلاكهم لشهادات عليا وخبرات روحيّة وعلميّة تؤهلّهم للمساهمة بفاعلية في قيادة الكنيسة.
على صعيد آخر، يعاني الإكليروس من تعيين أساقفة يفتقرون إلى الخبرة الإدارية والكاريزما الروحيّة، تمّ تعيينهم غالبًا وفق علاقات شخصية أو توازنات سياسيّة داخل المجمع، ممّا أدّى إلى تفريغ الإدارة الكنسيّة من جوهرها، وضعف ثقة الشعب بالإكليروس. كثير من هؤلاء الأساقفة أصبحوا عبئًا على الرعيّة بدل أن يكونوا خدّامًا لها، وتمّ إقصاء الأصوات المجددة وأصحاب الكفاءات خوفًا من زعزعة النظام القائم على الولاءات.
الأخطر من ذلك، تدهور صحة البطريرك يوحنا العاشر في السنوات الأخيرة، نسأل الله له الشفاء، مع صمته المستمر تجاه الأحداث والتحديات التي تواجه الكنيسة. هذا الصمت ترك الساحة لفئة ضيقة من الأساقفة والمستشارين الذين باتوا يديرون البطريركية وفق أجنداتهم الخاصة، مبتعدين عن هموم الشعب الكنسي وأحلامه. غابت بذلك القيادة النبويّة التي يُفترض أن تكون صوت الحقّ في الكنيسة مهما كلّف الأمر.
إنّ هذه الأزمة ليست مجرد عثرات إدارية أو خلافات تنظيمية، بل تمثّل تهديدًا وجوديًا لمستقبل الكنيسة ومكانتها كمؤسسة روحيّة حيّة، قادرة على تجسيد رسالة الدين الحقيقية بين أبنائها ومحيطها. وفهم هذه الأزمة بعمق يشكّل الخطوة الأولى الضرورية نحو طرح الحلول الجذرية التي تعيد للكنيسة أنفاسها ولشعبها الثقة بقيادتها.
هل من أمل؟
ليس هدف هذا المقال توجيه اللوم أو تهديد المؤسسة الكنسيّة بالانقسام، بل هو دعوة صادقة للمؤسسة إلى مراجعة نفسها بوعي ومسؤولية، قبل أن يُفرض عليها التغيير من الخارج. فالحركات الإصلاحيّة، مثل "حركة التغيير الأنطاكي" والأصوات الأكاديميّة اللّاهوتيّة المؤثرة، ليست تهديدًا للكنيسة، بل هي دليل على وجود من يؤمن بها حقًا ويريدها أن تظل صوت الإنسان الحر، لا مجرد صدى للسّلطة.
إنّ الكنيسة التي لا تُجري نقدًا ذاتيًا، ولا تُنصت لصّوت العلمانيين والعلمانيات، ولا تنفتح على المجتمع المدني، ولا تفصل اللّاهوت عن السياسة، محكومة بأن تفقد جوهر رسالتها. أمّا الكنيسة التي تواجه الحقيقة، مهما كانت مرّة، فهي وحدها التي تملك مستقبلًا.

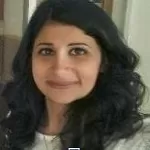
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_2_0_0_0_0.jpg.webp?itok=6WBSlKFQ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG-20250702-WA0045.jpg.webp?itok=lVwUcevi)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=rEyWt6ea)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9_0.jpg.webp?itok=9JSl_gMx)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_28_0.jpg.webp?itok=HT2ZxCOH)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%209999_0.jpg.webp?itok=yZ5Mfdm2)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%201_0_0.png.webp?itok=53WzJ7XI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_39_0.jpg.webp?itok=_oSIrZI1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20_0_0.jpg.webp?itok=QSyTIDUA)




![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_85_0.jpg.webp?itok=KEN7a-8y)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_0.jpg.webp?itok=CG6kMAYS)




![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)

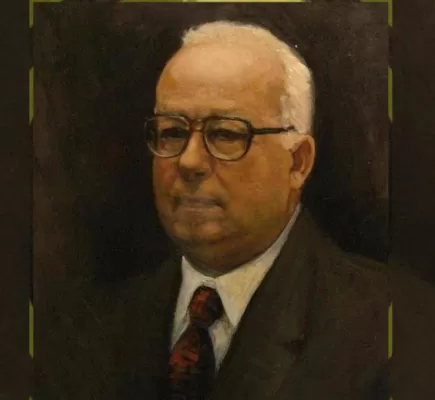


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)
