
خصصت شبكة (الإندبندنت) بالعربية تقريراً وافياً للحديث عن كيفية توظيف "حركات الإسلام السياسي" الدين من أجل السياسة، ومتى وأين ظهرت، وأيّ أهداف وغايات سعت إليها، وبأيّ طرق وأساليب، وكيف كان "الإخوان" أبرز تلك الحركات.
وبينت الشبكة أنّ من بين أبرز الحركات والتنظيمات التي "تلاعبت" على صعيد أهدافها وغاياتها بأتباعها، بحسب ما يرى منتقدوها، على مدار نحو قرن من الزمان، يتربع "تنظيم الإخوان المسلمين"، الذي وإن صُنف في عدد من الدول "جماعة إرهابية"، فإنّ طبيعته ضمن المنضوين تحت راية "الإسلام السياسي" وقدرته على توظيف الدين "سياسياً" ما تزال محل نقاش وبحث بين الباحثين والمتخصصين والمؤرخين، بدءاً من لحظة تأسيسه على يد حسن البنا في آذار (مارس) 1928، مروراً بمحطات الانتشار والحصار والاقتراب والابتعاد من السلطة، وصولاً إلى الملاحقة والتضييق إثر اتهامات بممارسة "العنف والإرهاب".
يشير مصطلح "الإسلام السياسي" بصورة رئيسة، وفق ما أجمع عليه غالب الباحثين والمؤرخين، إلى توصيف تلك الحركات التي تؤمن بالإسلام باعتباره "نظاماً سياسياً للحكم"، وأنّه "ليس عبارة عن ديانة فقط، وإنّما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة"، لهذا فإنّ بعض الحركات تسعى إلى إقامة "الخلافة الإسلامية" بصورة عالمية، مثل "حزب التحرير"، وبعضها إقليمي يهدف إلى إقامة دولة إسلامية تتجاوز القطرية العربية، كما هي الحال بالنسبة إلى "الإخوان المسلمين"، وأخيراً حركات ذات طابع محلي ينحصر عملها في إطار دولة معينة كما هي الحال بالنسبة إلى الحركات الإسلامية في غزة وأفغانستان.
محطة سقوط "الخلافة العثمانية" في عام 1924 تبقى نقطة فاصلة في مسيرة حركات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان.
وأكد التقرير الموسع أنّ محطة سقوط "الخلافة العثمانية" في عام 1924 تبقى نقطة فاصلة في مسيرة حركات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، حيث محاولات "إحياء مجد ضائع قديم في الدولة الإسلامية والخلافة".
وقال الباحث مقتدر خان، وهو أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ديلاوير، وزميل معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم، حول رؤيته لما يُسمّى "الإسلام السياسي" في مجلة (العلاقات الدولية): إنّه على رغم ربط الإسلام السياسي ببعض الأسماء بعينها مثل حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمه، فإنّ للمصطلح تاريخاً أبعد من ذلك يقوم على رثاء مجد ضائع قديم"، موضحاً: "كان عدد من المفكرين والعلماء المسلمين منذ بداية الحقبة الاستعمارية وبداية هيمنة الغرب على الدول الإسلامية في رثاء وندب لضياع الإمبراطورية الإسلامية وقوة ومجد الإسلام. وكانت اللحظة الرئيسة التي تبلور فيها الشعور بتراجع السلطة الإسلامية عندما اختفت الإمبراطورية العثمانية تماماً عام 1924، على رغم ما كان فيها من أزمات وتدهور، وعليه ظهر عدد من الحركات الإسلامية التي تحمل هدفاً واضحاً يتمثل في إحياء الأمّة الإسلامية وإصلاح المجتمعات المسلمة واستعادة مجدها السابق".
وتُعرّف الموسوعة البريطانية "الإسلام السياسي"، نقلاً عن وزارة الخارجية الإنجليزية، بأنّها تلك الحركات الساعية إلى "تطبيق القيم الإسلامية في الحكومات الحديثة، من خلال المشاركة في العملية السياسية، وفي بعض الحالات تكون هذه المشاركة تكتيكية، وليست مستمدة من إيمان أو التزام بالقيم والديمقراطية، ويمكن أن يشمل مفهوم الإسلام السياسي جماعات متطرفة ومعارضة للديمقراطية، أو معادية للغرب والليبرالية".
ويحصر المفكر الأمريكي وعالم الاجتماع آصف بيات في كتابه "ما بعد الإسلاموية: الأوجه المتغيرة للإسلام السياسي" غايات حركات الإسلام السياسي الرئيسة في "بناء مجتمع إيديولوجي نقي تتحقق فيه مُثل الإسلام، وإنّ سعيهم تاريخياً إلى السيطرة على الدولة وأسلمتها هي الطريق الرئيسة لتحقيق هذه الغاية، لأنّهم يعدّون الدولة هي المؤسسة الأقوى والأقدر على إقامة الخير ومحو الشر من مجتمع المسلمين".
تنظيم الإخوان وزعيمه عزز اللعب على التناقضات بين القصر والملك فاروق من ناحية، والأحزاب السياسية من ناحية ثانية، والسفارة البريطانية في القاهرة من ناحية ثالثة، والألمان من ناحية رابعة.
إلى ذلك، قال سونر جاغابتاي زميل أقدم في برنامج "بايير فاميلي" ومدير "برنامج الأبحاث التركية" في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى: إنّ "الإسلام لا يعني الإسلام السياسي، بل إنّ الإسلام هو الإيمان، والإسلام السياسي هو إيديولوجية متطرفة وعنيفة أحياناً وغير تاريخية، تسعى إلى كسب شرعيتها عبر الإسلام، وتركز جهود التجنيد التي تقوم بها على المسلمين. ويهدف الإسلام السياسي إلى خلق نظام عالمي غير ليبرالي جديد يأخذ تبريره من الماضي المتخيل والصارم".
ويوضح جاغابتاي، في دراسة له نشرها بمعهد واشنطن في أيار (مايو) 2015 تحت عنوان "هل المسلمون إسلاميون؟"، أنّ "العلاقة بين الإسلام والإسلام السياسي هي أقرب إلى العلاقة بين الطبقة العاملة والشيوعية في الحرب الباردة. فقد حاولت الإيديولوجية الشيوعية استخلاص شرعيتها من الطبقة العاملة وسعت إلى التحدث باسمها. ويحاول الإسلام السياسي أن يفعل الشيء نفسه، رغم أنّه لا يُمثل المسلمين في أيامنا هذه".
واعتمد التقرير العنوان الفرعي: "الإخوان واللعب على "التناقضات" لإظهار كيف استخدم مؤسسة الجماعة الدين وسيلة لتحقيق غاياته، وفي صراعاته مع السلطة في مصر والخارج.
وتابع التقرير: إنّ التنظيم الذي نشأ بعد (4) أعوام من سقوط الخلافة العثمانية، وسرعان ما انتقل إلى القاهرة، ثم إلى بقية أنحاء مصر، منطلقاً إلى العالم العربي والإسلامي، ترتكز مفاهيمه في "استعادة الخلافة" على مقولات حسن البنا بأنّ "الإسلام دين ودولة".
وأوضح التقرير: "في تلك الفترة التي لم يكن العالم قد تجاوز فيها بعد تبعات الحرب العالمية الثانية، وجد التنظيم الفرصة سانحة للانتشار واللعب على التناقضات في الداخل والخارج. فبحسب ما كتبه المؤرخ البريطاني الشهير مارتن فرامبتون في كتابه "الإخوان المسلمون والغرب: تاريخ العداوة والارتباط"، كانت "أعوام الحرب الباردة حاسمة فيما يتعلق بالمرحلة التكوينية لتنظيم الإخوان"، موضحاً أنّ "التنظيم وزعيمه عزز اللعب على التناقضات بين القصر والملك فاروق من ناحية، وبين الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الوفد والسعديون، من ناحية ثانية، والسفارة البريطانية لدى القاهرة من ناحية ثالثة، والألمان والإيطاليين من ناحية رابعة. وأقام علاقات مع كل هذه الأضداد، بعضها في العلن، وبعضها في السر، مثل الاتصالات بين البنا ومساعديه مع مسؤولين سياسيين أو عناصر استخبارات بريطانية. وفي تحالفاته المتضادة والمتضاربة هذه ضمن التنظيم بقاءه بعيداً عن التطويق، بل على العكس استفاد مالياً وسياسياً من كل هذه الأطراف".
وعن رصد العلاقات الشائكة بين الجماعة والدولة طوال عقود ما بعد ثورة تموز (يوليو) أوضحت دراسة بعنوان "علاقة جماعة الإخوان المسلمين بأنظمة الحكم في مصر... منذ العهد الملكي حتى عام 2021"، نشرها مركز (تريندز للبحوث والاستشارات)، أنّه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر "مرت علاقة الدولة بالجماعة كذلك بمرحلتين: الأولى مرحلة التعاون والتحالف (1952-1954)، وتميزت هذه المرحلة بنوع من الهدوء الحذر، أمّا المرحلة الثانية، فهي مرحلة الصدام والحل، وذلك بعدما قام الإخوان في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1954 بمحاولة اغتيال عبد الناصـر في الإسكندرية".
أمّا في عهدي أنور السادات وحسني مبارك، فقد اختلفت رؤية وطريقة تعامل كلٍّ من الرئيسين؛ ففي حين حاول السادات "توظيف الإخوان" لمساعدته في مواجهة خصومه السـياسـيين عقب توليه الحكم، ذهب مبارك إلى التعامل معهم بحذر شديد، إلا أنّه كانت هناك سمات مشتركة بينهما في سبل تعاملهما مع الجماعة، إذ رفض كلاهما إضفاء الشـرعية القانونية عليها، حتى مع السماح لها بالعمل السـياسـي والاقتصادي والاجتماعي، وفق (تريندز).
وأكد تقرير (الإندبندنت) أنّ الأعوام التي تلت سقوط نظام مبارك في مصر عام 2011 وبدايات صعود "الإخوان" إلى سدة الحكم في البلاد للمرة الأولى في تاريخهم، مفصلية وكاشفة بالنسبة إلى نيات التنظيم وقدرته على "توظيف الدين" لخدمة مصالحه، كما لم تظهر أيّ مرحلة سابقة في عمر الجماعة. فبدءاً من أحداث "الثورة" اتّسم موقف "الإخوان" بالتناقض بداية من تأكيد عدم المشاركة في التظاهرات، مروراً باعتبار مشاركة بعض الشباب في التظاهرات مشاركة فردية، وصولاً إلى ادعاء التحريض على التظاهرات ودفع المواطنين إليها، وفي أعقاب نجاح الثورة وإطاحة مبارك، وجدت الجماعة حرجاً كبيراً في مواصلة رفع شعارات الحاكمية لله وتطبيق الشريعة، فقررت الخروج من ذلك المأزق عبر طرح جديد يتمثل في إنشاء حزب مدني يستند إلى مرجعية إسلامية أطلقت عليه اسم "حزب الحرية والعدالة"، وخاضت به الانتخابات التي حملت الرئيس السابق محمد مرسي إلى سدة الحكم في مصر، وجاءت هذه الخطوة باعتبارها حلاً يدفع عنها شبهة السعي إلى الخلط بين السياسة والدين وتوظيف الأخير لخدمة الأهداف السياسية، وفق ما يقول مراقبون.
وتابع التقرير: "وبعد الثورة تمكن الإخوان من الوصول إلى السلطة للمرة الأولى في تاريخهم بمصر، إذ حصدوا نحو 40% من مقاعد مجلس الشعب (تمّ حلّه لاحقاً) في أول انتخابات تشريعية بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 وشكّلوا أكثرية برلمانية للمرة الأولى في تاريخهم، ثم وصل محمد مرسي المنتمي إليهم إلى سدة السلطة في 30 حزيران (يونيو) 2012، قبل أن تتم إطاحته في 2013.
وخلال عام وجودهم في السلطة بين حزيران (يونيو) 2012 وتموز (يوليو) 2013 ظهرت نيات الجماعة الحقيقية تجاه المجتمع ومؤسسات الدولة، فقد تعاظم حجم الصدامات وتوالت الأزمات التي تجلت مظاهرها في محاولة الإخوان إصدار قانون جديد لتنظيم القضاء وأزمة إقالة النائب العام وحصانة مجلس الشورى والجمعية التأسـيسـية لوضع الدستور. ووصل الأمر إلى حدّ التطاول والاعتداء على السلطة القضائية، والدعوة إلى التظاهر تحت شعار "تطهير القضاء"؛ ممّا دفع الشعب المصري للخروج على حكمهم، معتبرين أنّ شعاراتهم التي جلبتهم إلى الحكم كانت تهدف إلى التلاعب بالمشاعر، وما هي إلا شعارات للحشد والتوظيف والتعبئة.
ويقول مدير "برنامج الأبحاث التركية" في معهد (واشنطن لدراسات الشرق الأدنى) سونر جاغابتاي مستذكراً حالة وصولهم إلى السلطة في مصر عام 2012 وتولي الرئيس المنتمي إليهم محمد مرسي مقاليد الحكم: "حينها بدأت الجماعة حملة لفرض إيديولوجيتها المبنية على عدم المساواة على الشعب المصري. وتولى الإخوان السيطرة على وسائل الإعلام والمحاكم، وأشاروا إلى نياتهم المتعلقة بتنفيذ الشريعة الإسلامية. وأدى ذلك إلى قيام تظاهرات حاشدة في معظم المدن الرئيسة في البلاد، وثار المصريون ضد ما اعتبروه على نحو محقٍّ بأنّه الاستبداد الإسلامي السياسي الآخذ في التنامي".
وبعد عام 2013 انزلقت الجماعة في أزمة تنظيمية نتيجة إطاحتها من السلطة، وهو ما ترتب عليه حدوث انقسامات داخلية بلغت ذروتها عام 2021، فقد انقسمت الجماعة إلى تيارين أساسيين ومجموعات صغيرة أخرى.




![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_28_0.jpg.webp?itok=HT2ZxCOH)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG-20250702-WA0045.jpg.webp?itok=lVwUcevi)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%201_0_0.png.webp?itok=53WzJ7XI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/5b085b0a15fe9_0.jpeg.webp?itok=f27vg5Eu)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=rEyWt6ea)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_39_0.jpg.webp?itok=_oSIrZI1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%209999_0.jpg.webp?itok=yZ5Mfdm2)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9_0.jpg.webp?itok=9JSl_gMx)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20_0_0.jpg.webp?itok=QSyTIDUA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_8_0_0.jpg.webp?itok=E0FbgK-n)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_0.jpg.webp?itok=7FOOGTKJ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)





![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)
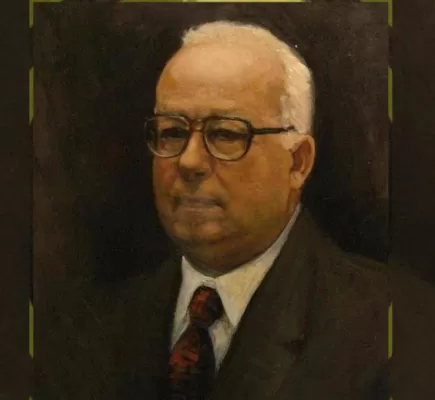


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)
