
حملت الفترة التأسيسية الأولى للدولة الإسلامية الأولى، التي أعقبت وفاة النبي محمد، وما جرى في سقيفة بني ساعدة، جدلًا واسًعا وخلافات حادة، أدت إلى انشطار الدولة الوليدة إلى مدارس ومذاهب وفرق، كان البون بينها شاسعًا وواسعًا، لم يقدر على رتق الخرق فيه أحد حتى الآن.
لقد تصدى لقراءة هذه الفترة التاريخية المهمة المئات من علماء التاريخ، والدعاة والوعّاظ، وغيرهم، وكان البون بينهم شاسعًا أيضّا، إذ بعضهم تناوله من وجهة نظر غير محايدة، مالت إلى جهة علي وكفّرت أعداءه والذين تخلوا عنه، وأعقب ذلك فقه وعقائد وأسانيد خصمت الدين من ملايين المسلمين لأنّهم لم يُكفّروا معاوية وجنوده.
على الناحية الأخرى، كان هناك من يرون الصمت عن تناول هذه الحقبة التاريخية، مرددين القول الشهير: إننا لم نشهد قتالهم، لذا فلا بدّ أن نكفّ ألسنتنا عمّا جرى بينهم، فإنّ ما وقع في عهد الصحابة من القتال، أو تركه، كان باجتهاد منهم في الجملة، والذي ينبغي لنا هو أن نكفّ عمّا شجر بينهم، وأن نعقد قلوبنا على محبتهم، ونطلق ألسنتنا بالثناء عليهم، مع القطع بأنّهم كانوا غير معصومين، ولكن ما يقع منهم من الخطأ هو باجتهاد مغفور، ومذهب أهل السنّة والحق إحسان الظن بهم، والإمساك عمّا شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأنّهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية، ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنّه المحق، ومخالفه يأثم، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، وكان بعضهم مصيبًا وبعضهم مخطئًا معذورًا في الخطأ، لأنّه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ فلا إثم عليه.
كان هناك من يرى من الفريق السابق وجوب التصدي لما أطلقوا عليه "أحداث الفتنة" وإعادة توضيب الأحداث بما يؤدي إلى عدم إخراج الصحابة من قدسيتهم إلى بشريتهم، ولم يخلُ قرن من عشرات الكتب والمقالات لهذه المدرسة المذهبية، مثل كتاب (العواصم من القواصم) الذي يتم تدريسه في كل محاضن الإسلام السياسي السنّي.
المصادر التاريخية
على المنوال نفسه كان هناك من يطلق دعوات التقريب للمذاهب، وهي دعوات سياسية أكثر منها دينية، فرغم بلوغ هذه الدعوات الآلاف، إلا أنّه لم تنجح منها محاولة واحدة، مثل إعادة قراءة أو ضبط أو مراجعة النصوص التاريخية لأحداث هذه الفتنة، والتي كلها وردت من مرويات تاريخية لم تخضع للتمحيص والنقد، أو تتعرض للشروط نفسها لقبول الحديث الصحيح، والحسن... إلخ
ومن المعروف أنّ مصادر كتاب التاريخ، هي المرويات التاريخية، مثل البداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الطبري، والكامل لابن الأثير... إلخ، وأغلبها تعتمد على نقل كل ما ورد في الأحداث التاريخية المستهدفة دون تمحيص، بل إنّها يمكن أن تنقل لنا الشيء ونقيضه، أو تنقل لنا مرويات ضعيفة كما هي، لذا فهي تتطلب جهدًا مضاعفًا لاختيار النص من بين المئات من النصوص المماثلة.
المرويات التاريخية، مثل البداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الطبري، والكامل لابن الأثير، تعتمد على نقل كل ما ورد في الأحداث التاريخية المستهدفة دون تمحيص.
ومن المصادر كذلك مذكرات الأشخاص أبطال الواقعة التاريخية، والوثائق التاريخية، ومراسلات الحكومات والقادة، وكتب المؤرخين... إلخ
إذا رجعنا إلى مصادر أحداث الفتنة الكبرى، فسنجد أنّ أغلبها من هذه المرويات، التي كتبت في سياق فترات تاريخية متباعدة، وتحكمها ظروف سياسية خاصة، مثل تلك المرويات التي كتبت في عهد الأمويين أو العباسيين، لذا فإنّ مصادر التاريخ، ومروياته، هي إشكالية في حدّ ذاتها حال التصدر للكتابة بحيادية، وحين كتب د. عماد الدين خليل كتابه دراسة في السيرة كان عدد صفحاته قليلًا جدًا، لأنّه اعتمد على منهج علمي، وكان غرضه عرض الأحداث المتفق عليها.
مناهج القراءة التاريخية
وحين تنتقل من تحديد مصادر الكتابة، يجيء الدور الأهم، وهو قراءة الأحداث التاريخية، وهي تقنية في حدّ ذاتها لفهم وتحليل الأحداث التاريخية وتفسيرها بطريقة علمية، وتتضمن مجموعة من الخطوات والأساليب مثل تحليل المصادر، والتحقق من صحتها، ثم تحليل السياق لفهم الظروف المحيطة.
وسنجد فيما سبق مدارس متنوعة، فاليساريون على سبيل المثال يرون أنّ أحداث التاريخ كلها كانت من أجل المادة، وأحداث ما حصل بين الصحابة كان من أجلها، وبعض المدارس الأخرى يفسر التاريخ من جانب بطولي، ويعتمد على أنّ البطل هو محور الأحداث التاريخية، مثل (عبقرية عمر) ... إلخ
وهناك من يفسر التاريخ من جانب مؤامراتي، أو إحصائي، أو جبري، وتيار الإسلام السياسي يرى أنّه لا بدّ حين التصدي لتفسير التاريخ أن يكون ذلك بتقييم الحق والباطل، وأنّه صراع لا ينتهي محسوم للحق.
لذا لتقييم كلّ ما كُتب عن الأحداث التي جرت للصحابة، يجب أن نعلم أوّلًا مصادر الكتابة، ثم المنهج البحثي والتحليلي لها، لأنّ ذلك سيضعنا على الطريق القويم.
وبتطبيق ذلك على صراع علي بن أبي طالب ومعاوية، يمكننا أن نرى عدة مدارس في هذه المسألة وفق المصادر والمناهج؛ وهذه المناهج كالتالي:
الأوّل يرى أن عليًّا بن أبي طالب، من آل البيت، وهو محكوم له بالصلاح والإمامة، وقد أوصى له النبي بالخلافة من بعده، وفي هذه المسألة إفراط آخر يرى بتكفير من عادوه وتولوا الخلافة قبله، وبعضهم يرى بقبول ما حصل على مضض، وبنقده ورفضه فقط.
على الجانب الآخر هناك من يرى أنّ معاوية رجل سياسة، وقد أسس دولة قوية، قدمت خدمات جليلة للإسلام، وأنّ عليًّا رجل موعظة ودين، ولو تولى الخلافة لانحصر الإسلام في المدينة ومكة، وأمّا معاوية فقد أسس لانتشار الإسلام، وقيام ملك كبير للمسلمين.
المنهج الثالث يرى أنّ هناك مؤامرة على الإسلام، صنعها اليهود، وكانت قبل بعثة النبي باغتيال والد النبي عبد الله، ثم محاولات اغتيال النبي في المدينة، وبعدها الفتنة التي صنعوها بين الصحابة، وفي التراث الديني جملة فيما يُعرف بالإسرائيليات.
وأمّا المنهج الأخير، فهو الذي يرى الصمت، وعدم تناول هذه الحقبة إلا بالاحترام والتقديس للجميع، مع الاعتراف بفضل عليٍّ على معاوية، وهنا يأتي مسلسل معاوية، ليخترق تلك الحالة، ليقول بالرأي الثاني، وينحاز لمعاوية رجل السياسة القوي، ضد عليّ رجل الدين الضعيف، مع اعترافنا بأنّ الدراما هي للمتعة والتسلية، وليست لقراءة التاريخ.


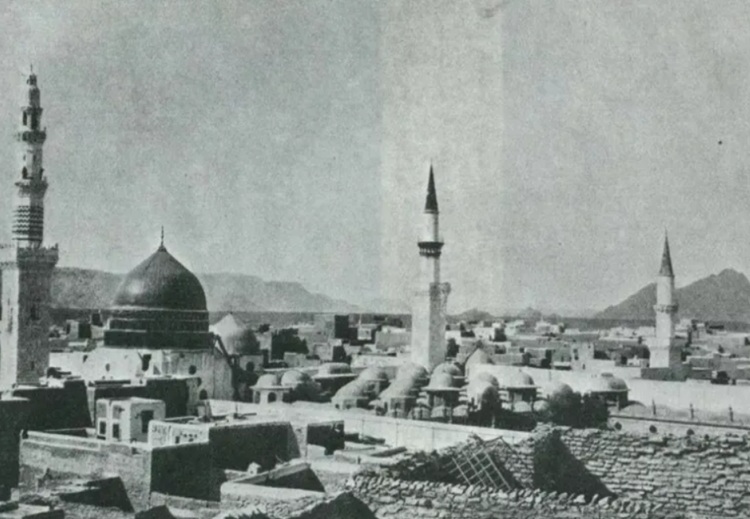

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B8_1.jpg.webp?itok=OFwnxSCn)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/macron-sisi_0_0.jpg.webp?itok=lPFzOQpK)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_44_0.jpg.webp?itok=EfRcINOU)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_94_0.jpg.webp?itok=h9IzVUjE)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D8%B1%D8%AF_0_1.jpeg.webp?itok=P80LN0oF)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%840.jpg.webp?itok=QXm-QoHN)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A_24_2_1_0_0_0.jpg.webp?itok=9RUG5bq0)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/Almawqea2025-07-01-03-50-49-397650.jpg.webp?itok=QMUPc86w)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/264205_3.jpg.webp?itok=S_ZzoLef)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_0.jpg.webp?itok=CG6kMAYS)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_85_0.jpg.webp?itok=KEN7a-8y)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_70_0_2_1.jpg.webp?itok=xPJQaPu3)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)



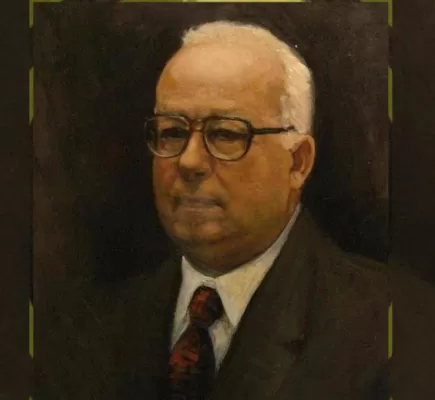
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/91390-revolutionswaechter_khamenei.jpg.webp?itok=pAsOmTB1)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)
