
تستحضر رواية "موانئ المشرق" التي كتبها اللبناني الفرنسي أمين معلوف عام 1991، أجواء الاحتراب الراهنة التي يعيش في أتون نيرانها الملتهبة العربُ والمسلمون في هذه القنطرة الرهيبة.
موانئ الشرق: كانت العلاقة الوطيدة بين تركي وأرمني غير مألوفة كثيراً آنذاك، وأكاد أقول إنها "خارج حدود الزمن"
وكان الكاتب يحلم، من خلال حكايته الروائية، أن يحقق فكرة التعايش المهجوس به في إطار من التسامح والاحترام الإنساني الذي حضّت عليه جميع الأديان. لكنّ مصير من يدعو إلى هذه القيم التي في طريقها للانقراض هو الجنون، فلا صوت للعقل والمنطق، والكل مطحونون، بألم ومرارة في مستشفى فسيح ومديد للأمراض العقلية.
يكتشف "عصيان" وهو الشخصية الأساسية في الرواية، أنّ مقاومة المحتل النازي كانت أبسط بكثير من مقاومة العداء الديني التاريخي ما بين المسلمين واليهود!
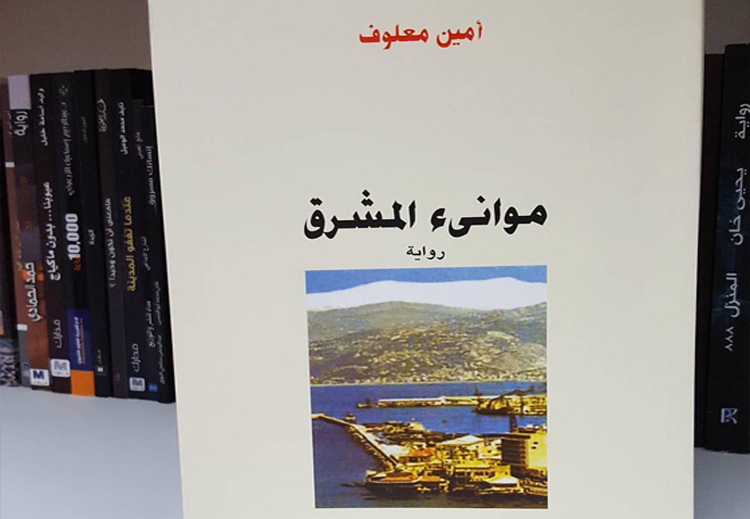
تُروى الرواية على لسان بطلها الأمير التركي "عصيان" الذي بدأ حياته منذ نصف قرن قبل ولادته في غرفة لم يزرها قط على ضفاف البسفور. وقعت مأساة ودوّت صرخة وانتشرت موجة جنون لن يُقدّر لها أن تهدأ. لذا فعندما أبصر النور، كانت خطوط حياته قد رسمت الى حدٍ كبير.
كما كان اسمه، مارس الأمير عصيانه مرتين، حين تمرّد على أبيه وهاجر إلى باريس، رافضاً الطريق الذي رسمه له أبوه في أن يكون ثائراً سياسياً على الوضع المتدني في أراضي أجداده ليدرس بدل ذلك الطب. ولكنه ما لبث أن اشترك في ثورة أخرى اختارها بملء إرادته. كان التمرد الثاني حين خرج من منفاه اللااختياري الذي احتجزه به أخوه في المصح النفسي.
كان أمين معلوف يحلم أن يحقق فكرة التعايش المهجوس به في إطار من التسامح الذي حضّت عليه جميع الأديان
يتناول الكاتب من خلال حياة بطل القصة، موضوعه الأثير .. "المواطن العالمي"! فعصيان هو ابن رجل مسلم تركي وأم مسيحية أرمنية، وزوج يهودية من أصل نمساوي، وتنقّل بين موانئ المشرق كالبسفور وبيروت وباريس وفلسطين.
وبالتالي، فإنّ في حياة بطل القصة المتحدّر من سلالة السلاطين العثمانيين والممزوجة بدم أرمني، ما يجعله يمقت "الحقد العنصري" ويقدم الحل في رفض مثل هذه الأحقاد في هيئة مقاومة مشتركة بين المتناقضات في وجه أعداء الإنسانية.
ولد أمين معلوف في بيروت في 25 شباط (فبراير) 1949، وامتهن الصحافة بعد تخرجه، فعمل في الملحق الاقتصادي لجريدة "النهار" البيروتية. وفي عام 1976 انتقل إلى فرنسا، حيث عمل في مجلة "إيكونوميا" الاقتصادية، واستمر في عمله الصحفي فرأس تحرير مجلة "إفريقيا الفتاة" أو "جين أفريك".
اقرأ أيضاً: تجليات النقد والتنوير عند طه حسين
أصدر أول أعماله "الحروب الصليبية كما رآها العرب" عام 1983، عن دار النشر لاتيس التي صارت دار النشر المتخصصة في أعماله. ترجمت أعماله إلى لغات عديدة، ونال عدة جوائز أدبية فرنسية منها جائزة الصداقة الفرنسية العربية عام 1986 عن روايته "ليون الأفريقي"، وحاز على جائزة الجونكور، كبرى الجوائز الأدبية الفرنسية، عام 1993 عن روايته "صخرة طانيوس".
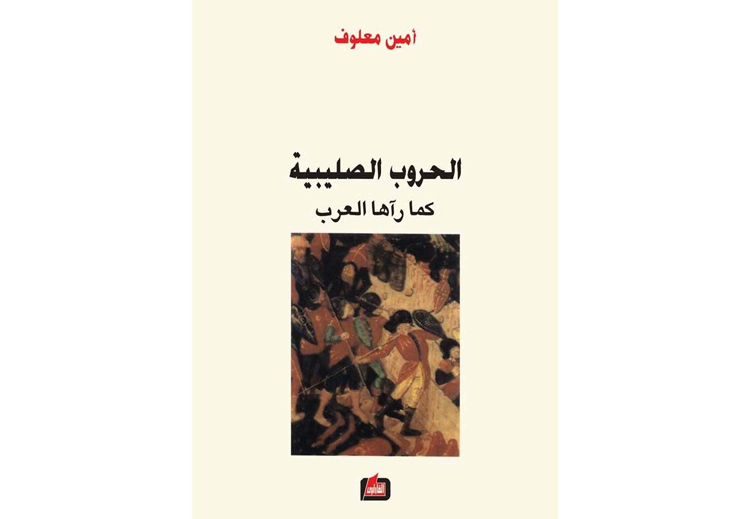
له روايات عديدة من بينها "سمرقند"، "حدائق النور"، "التائهون". كما أصدر كتباً تضمنت مقالات سياسية تاريخية من بينها "الهُويات القاتلة" و"اختلال العالم".
اقرأ أيضاً: هل يحتاج التيار التنويري إلى وقفة نقد ذاتي جريئة؟
في روايته "موانئ المشرق"، يظل أمين معلوف يراود المستحيل، مؤكداً أنّه "حتى عندما لا نبصر نوراً في نهاية النفق، يجب أن نؤمن بأنّ النور لا بد أن يظهر".
وهنا مقاطع من روايته، التي صدرت عن دار الفارابي في بيروت، وترجمتها نهلة بيضون:
***
سألني:
- بماذا تريد أن نبدأ الحديث؟
- الأفضل أن نبدأ من البداية، من ولادتك ..
تمشّى دقيقتين كاملتين بصمت، ثم أجاب بسؤال :
- أواثق أنت أنّ حياة الإنسان تبدأ يوم ولادته؟
لم يكن ينتظر جواباً، بل كان سؤاله مجرد أسلوب لبدء روايته، فتركت له الكلام مصمماً على التدخل بأقل قدر ممكن.
***
تشاور الخدم على أنّ شخصاً واحداً في العالم يمكن أن يعصي أوامره دون أن يصب السلطان جام غضبه، وهذا الشخص هو ابنته الأثيرة، إيفيت. كان الاثنان يتبادلان أعمق آيات الحب، وهو لا يرفض لها طلباً، فاستقدم لها مدرسين علموها عزف البيانو والغناء والفرنسية والألمانية، وكانت تجرؤ في حضرته على ارتداء الزي الإفرنجي الذي يأتيها من فيينا أو باريس .
***
ذلك أننا نستطيع أن نفكر عكس ذلك أيضاً: فكيف للزوج الطبيب الذي لايفارق زوجته، ويلبسها ثيابها ويخلعها عنها ويحممها كل مساء وهي المرأة الشابة والجميلة التي يعشقها بكل جوارحه، لدرجة أنه كرس لها كل لحظة من حياته ـ كيف له أن يتأملها دون أن تجرفه عاطفته الجياشة؟
كانت هذه العلاقة الوطيدة بين تركي وأرمني غير مألوفة كثيراً آنذاك، وأكاد أقول إنها "خارج حدود الزمن" بل وتحوم حولها الشبهات كذلك، لقد حافظ الأتراك والأرمن على علاقات عمل ولياقات اجتماعية واحترام متبادل، أما الصداقة الحقيقية والانسجام العميق فهذا ما لم تشهده تلك الفترة، فالعلاقات بين الطائفتين كانت تتدهور سريعاً .
كان والدي، إذا شئت نموذجاً لما ندعوه عادةً بالمستبد المستنير، كان مستنيراً لأنه أراد لنا تنشئة الرجال الأحرار، ومستنيراً لأنه حرص على تعليم ابنته وابنيه على قدم المساواة، ومستنيراً كذلك في شغله بالعلوم الحديثة والفنون، ولكنه كان مستبداً أصلاً، في الطريقة التي يعبر فيها عن أفكاره ...
كنت قد استأجرت غرفة تقع في سقيفة فسيحة ومتشققة، لدى امرأة تدعى السيدة بيروا، وإذا ارتقيت السلالم اللامتناهية، وأدرت المفتاح الضخم في قفل الباب، كنت لاأزال ممعناً في التوبيخ والتأنيب. لن أطأ أبداً عتبة تلك الحانة! ولن أنساق البتة وراء هذا النوع من الشجار! ألم أعاهد نفسي على التحصيل والدراسة، ولا شيء سواهما؟ لقد أخطأت ...
***
في تلك اللحظة لم أقل لنفسي "أحبها"، لا لنفسي ولا - بالأحرى- لها، وما سأقوله قد يبدو مضحكاً .. كنت أشعر بكل أعراض الحب المفتون ولكن الكلمات لم تحضرني، ويبدو أن المرء بحاجة في مثل تلك اللحظات إلى صديق صدوق يتلفظ بكلمة "عاشق" حتى وهو يهزأ منك حتى ولو كان سيئ النية بالمطلق، من أجل أن تطرح على نفسك السؤال عينه، وحينئذ تتيقن من الجواب !"
***
ثم وصلنا في حديثنا إلى معركة شمال إفريقيا والأنباء الأخيرة ومفادها أنّ موسليني يستعد للدخول ظافراً إلى مصر، وعندما انسحبت مضيفتنا بدورها وكانت تتثاءب منذ بعض الوقت، قائلة: "لاداعي للخلود إلى النوم على الفور، أكملا كأسيكما بهدوء "
وانصرفت، فخيم الصمت فجأة، وتعذر استئناف الحديث فقلت كما لو أنني أقرأ من كتاب:
ـ يبدو أنّ دانييل قد اصطحبت الحديث معها سهواً.
وسمعت الضحكة نفسها التي صدحت بها الضيفة أثناء العشاء، كانت ضحكة مرحة وحزينة معاً، طليقة ومنخفضة، كانت أعذب موسيقى في الكون! وهاتان العينان اللتان تغوران أمامي!
وسألتني على حين غرة :"بماذا تفكر؟"
كان الأمر يتطلب مني الكثير من الوقاحة لأجيب ببساطة " أفكر بك !" لذا فضلت الإجابة بصورة ملتوية ـ كنت ألعن الحرب ....
***
للطبيب كتابديار نظرياته؛ إذ يعتقد أنّ امرأة مثلها، فقدت رشدها نتيجة صدمة، ستسعيده بصدمة أخرى. الحمل، الأمومة والولادة بشكل خاص صدمة حياة قوية تنهي صدمة موت قوية. الدم يمحو الدم. نظريات .. نظريات.
أصغت إليّ كلارا مقطبة الجبين وهي تهز رأسها كما لو أنني أعلمها بأمر بالغ الخطورة ثم نظرت حولها، وإذا اطمأنت إلى عدم وجود أي كائن طبعت على شفتي قبلة خاطفة كأنها نقرة عصفور .
عندما صحوت من المفاجأة، كانت قد صعدت على السلالم مهرولة، وانصرفت بدوري، يا إلهي، كم كانت السماء زرقاء في ذلك اليوم !"
***
المأزق الذي استمر ثماني وعشرين سنة:
بقيت مخبولاً، وأعني أنني خبلت أكثر من العادة، ذلك أنّ الخبل كان الوضع الطبيعي، ولذا قدم لي العزاء على طريقته: ـ إنّ ما يجري لايجب أن يدهشك يا عصيان، فشقيقك سوف يتفوق عليك دائماً عليك بميزة لا تتمكن أن تضاهيه فيها.
ـ وماهي؟
ـ إنه شقيق مقاوم سابق، أما أنت فلست سوى شقيق مهرب سابق.
***
لم تعد ابنتي لزيارتي أبداً. وأنا لا ألومها، فلماذا تعود؟
لإنقاذي؟ لقد أنقذتني أصلاً، ونطقت بالكلمات الشافية. كنت أستعيد صوابي وأتسلق ببطء جدران هاويتي الداخلية، وأصارع! أصارع لتبديد الغشاوة واستعادة بصيرتي، وترميم ذاكرتي، وإحياء رغباتي وإن تعذبت لعدم قدرتي على إشباعها ..كانت معركة أخوضها بمفردي .
وقد خضتها بحكمة مضاعفة، فثابرت على مراقبة رفاقي في المحنة لمحاكاة تصرفاتهم وعادتهم، إذ صرت أدرك يوماً بعد يوم أن لا شيء حقاً كان مماثلاً بين حالة التخدير وحالة اليقظة. وهكذا لم يكن إيقاع الكلام أو النبرة أو "التأوهات" التي تختفي ـ هذه الأصوات التي تطيل الجمل والمفردات والحروف ـ بل كانت مفرداتي هي التي تتحول، فثمة كلمات ينساها المرء عندما تتخدر الرغبات التي تدل عليها.
اقرأ أيضاً: التنوير بين مطرقة التسطيح وسندان الهمجي النبيل

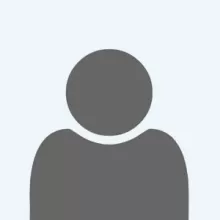
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_2_0.jpg.webp?itok=otxkpinA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A%20%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_0.jpg.webp?itok=ZR39Fb2J)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_168_1.jpg.webp?itok=ob6fEx8E)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%B9%D8%B2_38_0.jpg.webp?itok=-i7ddVB-)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_3_0.jpg.webp?itok=iwXub7Xq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86_21_3_0_0_2_1.jpg.webp?itok=sjdsCZFV)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_57_3_0_0_0_1_1.jpg.webp?itok=h8cayXFz)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/6692ba7c42360468fb5f62f7_1_1_3_1.jpg.webp?itok=JZyn7Z4V)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8_0.jpg.webp?itok=MATErgrH)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_132_0.jpg.webp?itok=JYIosZSp)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_7_1_1_1.jpg.webp?itok=XnK415rC)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8688_0_3_1_7_8.jpg.webp?itok=hWvwe5m8)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_32_0.jpg.webp?itok=s9Fag33l)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_22_2_0.jpg.webp?itok=mAF6t0TM)







![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)
