
نشرت مؤسسة (ميلسون)، خلال هذا العام 2024، كتاباً للمفكر السوري المقيم بألمانيا، حسام الدين درويش، تحت عنوان: "منمنمات فكرية وحوارية في الفلسفة ". وقد جاء الكتاب على شكل مجموعة من المواضيع المنطلقة من المجال الفكري المعرفي والأخلاقي، إلى المجال الحواري.
الكتاب تضمن بابين؛ ضمن كل باب كان هناك فصلان، وقد أثار في أحد الفصول إشكالية تعاطينا مع مفهوم الديمقراطية في السياق العربي، أو كما سمّاه النقد غير الديمقراطي للديمقراطية. ويستعرض الكاتب مجموعة من التدخلات التي تناولت الموضوع على إثر المعرض الدولي للكتاب 2023، وهي تدخلات تخص بعض المفكرين التونسيين: أمثال محمد محجوب، فتحي التريكي، حميد بن عزيزة، الشريف الفرجاني، آمال قرامي، وكان غرض الكاتب الأساس تسليط الضوء على نموذج سجالي غير صحي أو متناقض مع ذاته، غالباً ما نتعايش معه في الفضاء العمومي العربي. إذ الحوار حول مفهوم الديمقراطية، بطريقة نقدية، من طرف المحاورين أثارت حفيظة حزب التحرير التونسي، وهو حزب إسلامي، ممّا جعلهم يعلقون على الندوة، أنّها ترنو نحو تقديس مفهوم الديمقراطية بما هو مفهوم غربي، ومن المعلوم أنّ مثل هذه التوجهات ذات التوجهات الدينية ترفض أو تتوجس من التناول الإيجابي لمثل هذه المفاهيم، لأنّها مفاهيم دخيلة لا تناسب الهوية الدينية، رغم أنّ هذه التوجهات هي نفسها تمارس هذا الرفض انطلاقاً من أرضية ديمقراطية؛ الأمر الذي حوّل اللقاء إلى جدل إسلامي علماني، وهو الجدل الذي ينتعش على الإطار الديمقراطي بالنسبة إلى التوجهين: الإسلامي والعلماني على حد سواء، فرغم أنّ التوجه الأول يعلن توجسه الدائم إزاء المفهوم، إلا أنّه ينتعش على فساحته الديمقراطية.
هذا الجدل، في الحقيقة، لا يعكس نموذجاً وحيداً، بل إنّه يمسّ طبيعة تعاطينا مع المفهوم في بُعده النظري وواقع الممارسة، فالتوجه العلماني يتجنب على حد سواء إعلان تبنيه بشكل صريح للعلمانية وأطروحاتها، لتجنب مهاجمة المفهوم أمام توجهات إسلاموية، قد تتصيد هذا النقد للإطاحة بالديمقراطية نفسها، أو تعرّض أصحابها للنقد والمواجهة. رغم أنّ هذا التوجه يظل بشكل ما بعيداً عن تحديات المفهوم، إذ يغلب التقييم المعياري الإيديولوجي على الجانب المعرفي، وهو جدال سلبي وعقيم من كلا الطرفين، حسب حسام الدين درويش، لأنّ الطرفين يظلان في النهاية عاجزين عن توجيه النقد للمنظومة السياسية بشكل صريح، لأنّ الندوة تضمنت خلال المداخلات نقداً صريحاً ومضمراً للرئيس قيس سعيد في إطار نقد مفهوم الديمقراطية، لكنّ هذا النقد لم يتم تسجيله أو توثيقه بشكل رسمي، وتم حذف الجزء الذي تضمن نقداً صريحاً أو مباشراً، كأننا أمام مشهد لممارسة الديمقراطية في بُعدها الضيق أو تحويل المجال العام إلى مجال خاص بالنخبة، دون أن يتم تمريره إلى مسامع السلطة السياسية، وكما أنّ التوجه الإسلامي يواجه تضييقاً ومنعاً داخل تونس، لكنّه يحاول أن ينعش روحه من الحركية الفكرية في مثل هذه المناسبات الفكرية.
رغم أنّ الكاتب يرى أنّ أصوات المجتمع المدني الديمقراطي في تونس تظل قوية ويعتمد عليها، بمعنى ما، وقد تفتح باب أمل التحول الديمقراطي في تونس، إذا تم تجاوز هذا الصراع الثناني ما بين علماني/ ديني، وهو صراع يعكس توجهاً معيارياً أكثر من كونه معرفياً، لأنّ الديمقراطية تقتضي التخلص من الأحكام الإيديولوجية المسبقة وتبني بشكل وحيد وأوحد قيم الديمقراطية، بغض النظر عن التوجهات الإيديولوجية، ممّا يجعلنا نقول إنّ التوجه المدني الرزين الذي لا ينخرط بشكل عنادي في مقاربة مانوية ترفع شعار إيديولوجية معينة دون غيرها، بمقدوره أن يخلق جواً ديمقراطياً قوياً، لأنّ هذه المقاربة المانوية تنطلق من رؤية حدية تم تجاوزها في السياق الغربي، ولم يعد مفهوم العلمانية مشحوناً بما ينبغي أن يكون، أو مرادفاً لأفول الدين كما تقدمه الأطروحات التقليدية، ممّا يوهم بوجود صراع ما بين العلماني والديني، وقد يكون مفيداً للسياق العربي أن ينفتح على الأطروحات الجديدة حول عدة مفاهيم منها العلمنة والتقدم، إذ هناك ترابط ما بين الحداثة والتقدم، بشكل لا يقبل الانفصال، وهو اتصال ترجمته أنساق فلسفة التاريخ والعلوم الاجتماعية إبّان الأزمنة الحديثة، صحيح أنّ أطروحة التقدم قد تعرضت للعديد من الانتقادات، ويمكن التجذير لهذا التوجه النقدي في الخطاب الثاني لروسو في "أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر"، وقد استندت هذه الانتقادات إلى التأثيرات الضارة لسيرورة التحديث، ممّا استوجب مراجعة الترابط الوثيق ما بين التقدم والحداثة وبالإيجابية المعيارية الكاملة لكليهما، وإلى ضبط المفهومات المؤسسة لهما، وهو ما عكسته المراجعات الخاصة بمفهوم العلمنة والتقدم التي جرت خلال العقود الـ (5) الأخيرة، فلم يعد ممكناً القول إنّ الحداثة تقتضي بالضرورة أفول الدين أو المعتقدات والممارسات الدينية أو غياب الدين عن المجال العام، فالنظريات التقليدية الخاصة بسيرورة العلمنة، قد حولت عملية معرفة ما هو كائن في العالم الغربي إلى تقويم لما ينبغي أن يكون في عمليات التحديث والعلمنة كلها في جميع بقاع العالم.
لكنّ هذه المراجعات النقدية لم تحظَ بالحضور الملائم في النقاشات العربية، فحتى التوجه العلماني ما زال متمسكاً بأطروحة العلمنة التقليدية دون استحضار المراجعات النقدية الأخيرة، لهذا فإنّ الدرس الأهم، حسب الباحث، هو ضرورة الابتعاد عن الرؤى الجوهرانية المعيارية، التي تتبنّى مقاربة مثنوية مانوية، بحيث لا ترى إلا صيغة معرفية واحدة، وتقويماً معيارياً واحداً لتلك النظريات والمفهومات المرتبطة بها، فتنزع إلى رؤية أحادية تشيطن طرفاً أو أكثر، كما فعل وائل حلاق، على سبيل المثال، في رؤيته المعادية للحداثة والعلمانية وما سمّاه لاهوت التقدم.
إنّ هذا المنظور الذي يغلب على خطاباتنا يسم أيضاً مناظراتنا الشفهية، حيث يسود نوع من المثنويات أو الثنائيات القطبية، ويتجيش طرف يمثل الحق والخير، في وجه الطرف الآخر الذي يمثل الشر والقبح، وهو منظور في الحقيقة إيديولوجي يفتقر إلى الجانب المعرفي من كلا الطرفين، لأنّ الجانب المعرفي يظل متأرجحاً بين الحدين، دون أن يستقر عند أحدهما، وفي عملية تأرجحه تتمثل علميته، ممّا يخلق عمى إيديولوجياً يجعلنا أمام نزال لا معرفي، هدفه الأساس تحقيق النفي لهذا الآخر المخالف، فالاختلاف هنا يُعتبر خطيئة لا تُغتفر، يجب عدم التسامح معها.


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/5b085b0a15fe9_0.jpeg.webp?itok=f27vg5Eu)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20_0_0.jpg.webp?itok=QSyTIDUA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%201_0_0.png.webp?itok=53WzJ7XI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9_0.jpg.webp?itok=9JSl_gMx)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_28_0.jpg.webp?itok=HT2ZxCOH)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=rEyWt6ea)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_39_0.jpg.webp?itok=_oSIrZI1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%209999_0.jpg.webp?itok=yZ5Mfdm2)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_2_0_0_0_0.jpg.webp?itok=6WBSlKFQ)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_8_0_0.jpg.webp?itok=E0FbgK-n)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_0.jpg.webp?itok=7FOOGTKJ)




![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)


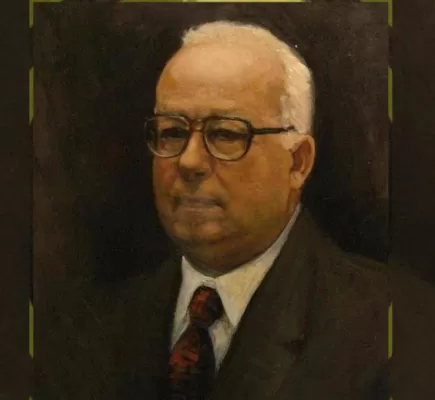


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)
