
أجرى الحوار: رامي شفيق
حددت الأكاديمية التونسية منية العلمي أنّ التطرف يعبّر عن أزمة فكرية موغلة في الانحراف.
بهذه العبارة تلخّص منية العلمي، المختصة في علوم القرآن والتفسير وقضايا الفكر الإسلامي المعاصر، في حوارها مع (حفريات)، رؤيتها لأحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم. فالتشدد لا ينشأ في فراغ، بل يتغذى على بيئات غير صحية، سواء كانت أسرية أو تعليمية أو اجتماعية، ممّا يسهم في تشكيل نمط تفكير مغلق يفتقد للمنهج النقدي ويعجز عن تنسيب الحقائق.
وفي هذا الحوار تؤكد منية العلمي الخبيرة لدى القطب الأمني لمكافحة الإرهاب أنّ التطرف لا يرتبط فقط بسوء فهم للنصوص الدينية، بل في كثير من الأحيان يكون تأويلاً متعمداً يخدم أجندات سياسية واقتصادية تسعى للهيمنة وإعادة برمجة الشعوب. وتشير إلى أنّ هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، إضافةً إلى الفراغ الفكري، يشكّلان بيئة خصبة للاستقطاب، حيث تعمل الجماعات المتشددة على استغلال هذه العوامل، سواء عبر المساجد أو الجمعيات أو حتى الفضاء الرقمي، لضمان ولاء الأفراد وتحويلهم إلى أدوات لتنفيذ أجنداتها.
نص الحوار:
بتقديرك كيف نحدد الأسباب والاعتبارات العميقة التي تغذي الفكر المتشدد في مجتمعاتنا؟
ـ يُعبّر التطرّف عن شكل لافت من أشكال المغالاة في الفكر والرأي والمعتقد، ومهما كانت مجالاته سياسية أو اجتماعية أو عرقية أو دينية، فهو لا يخرج عن كونه تعبيراً عن أزمة فكرية موغلة في الانحراف، ويعتبر البحث في أسبابه العميقة -كما تفضلتم في سؤالكم- بحثاً معقّداً ومتشابكاً، لعلّ أبرز آليّاته تتمثل في البيئات التي تسهم في تشكيل ذلك الفكر.
فكلّ البيئات، أيّاً كانت، أسرية، أو مجتمعية، أو تربوية تعليمية، أو غيرها ممّا تكون ذات علاقة بالتنشئة ويرتبط بها الفرد بشكل من الأشكال، إذا كانت غير صحية وغير متوازنة، فيمكن أن تؤثر في الفرد وتدفعه وتقوده، بل تجهزّه وتدّربه وتكيّفه على نمط واحد مغلق من التفكير والسلوك، وبالتالي تنزع عنه كلّ ميل نحو التفكير النقدي للظواهر، وللأفكار، وللمسلّمات من حوله، وطبعاً ما يعزّز استعداد الفرد وانقياده لكلّ ذلك، هو عدم تلقيه تعليماً متوازناً منفتحاً على المواد الفكرية والمناهج النقدية التي تحفّز العقل وتدّربه على تنويع المقاربات وزوايا النظر، وبالتالي تنسيب الحقائق، وفي غياب ذلك، ينشأ الفرد وينمو داخل بوتقة مغلقة من الأفكار والمشاعر والخيارات المحدودة، حيث يتقلص نشاط العقل الطبيعي والفطري، ليحلّ محله التقاعس عن طرح السؤال النقدي، والجرأة على طرحه.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم تكافؤ الفرص، وغياب العدالة الاجتماعية، كلّ ذلك يسهم بطريقة أو بأخرى في تنمية مشاعر الحنق والحقد، كما يسهم في بناء شخصيات ضعيفة متوتّرة مغتربة ومهمّشة، ممّا يلقي بها مباشرة بين أحضان الجماعات المتشدّدة، التي تضمّهم إلى عناصرها دون شروط أو قيود أو سيرة ذاتية أو سنوات خبرة مطولة، والتي تقدّم نفسها كمنقذ مقدّس، ويمثل هؤلاء الأفراد بخصائصهم تلك الخزّان البشري المطلوب للجهات المعنية بالاستقطاب داخل تلك الجماعات، فهي تعمل على استقطاب أمثالهم من المساجد، والمعاهد، والمقاهي، وحتّى من قاعات التدريب الرياضي والحمّامات.
هذا من دون أن نتحدّث عن مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تمثل الطريقة الأيسر والأكثر نجاعة وأماناً لاستقطاب العناصر الهشّة تعليمياً واجتماعياً واقتصادياً ونفسياً، دون أن تدخل الجهات المستقطبة في مخاطرة الوقوع بين أيدي الجهات الأمنية بفضل ما تتّخذه من إجراءات تقنية احترازية. فخلاصة القول في البحث عن الأسباب العميقة لصناعة ذلك الفكر، هو الاشتغال على تأكيد بُعد الأفراد عن التفكير وفقاً للمعايير القيميّة المشتركة بين المجتمعات الإنسانية، والابتعاد عن أسس التفكير العقلاني القائم على المنهج النقدي.
هل ينبغي اعتبار الفكر المتشدد نتيجة لسوء فهم النصوص الدينية، أم هو تأويل متعمد لأهداف سياسية؟
ـ بالنسبة إلى المؤسّسين والقياديّين في الجماعات الراديكالية، لا نعتقد أنّ الفكر المتشدّد هو نتاج لسوء فهم أو سوء توظيف النصوص الدينية، بل هو في رأينا تأويل منحرف متعمّد جدّاً خدمة لأجندات سياسية غايتها الاستيطان ونهب مقدرات الشعوب وثرواتها، وتقسيمها وإعادة برمجتها سياسياً وثقافياً وسلوكياً، فهذه عناصر يقع تجهيزها سلفاً في الغالب للقيام بمهمّات رذيلة خدمة لمشاريع الإمبريالية والصهيونية العالمية التي تدرك جيّداً أنّ المسلك الديني هو الطريق الأيسر للهيمنة على شعوب تعلو فيها نسب الجهل والأميّة، ولعلّ خير شاهد على ذلك ما نعايشه اليوم من حقائق مريبة في أوطاننا العربية المهدّدة بالانقسام وحتّى بالزّوال، على غرار فلسطين والعراق وسوريا وليبيا، وكما تعلمون فإنّ مشروع التقسيم هذا مشروع تشتغل عليه الصهيونية منذ فترة، حتى أنّها جنّدت لأجل تحقيقه جماعات أصوليّة تكفيريّة في أغلب الدول العربية والأفريقية ودعمتها ماديّاً ومعنويّاً، إمّا مباشرة وإمّا عن طريق المناولة، أمّا الأتباع والحشد المنتصر لتطبيق الشريعة وفقاً لمفهومه العاميّ، فهؤلاء ـوبصرف النظر عن المرتزقة منهم- ما زالت أذهانهم متمركزة حول مفاهيم دينية متشدّدة على غرار: الولاء والبراء، والحاكميّة، ممّا يقتضي تكفير المخالف، واستباحة كلّ متعلقاته، وتطبيق الشريعة بلا أدنى اعتبار لأيّ متغيّرات سياقيّة، ورفض المفاهيم والأنظمة الحديثة كمفاهيم الدولة المدنية والديمقراطية والمساواة...، وبمثل تلك الأفكار وما هو ظاهريّ من دعائمها النصيّة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة، وقع استقطاب تلك الأعداد الكبيرة من الشباب، والتأثير عليها وغسل أدمغتها، وإلّا فكيف يمكن لنا أن نجد معنى للعمليّات الانتحارية التي يقدم عليها شباب في عمر الزهور، بغاية الذود عن الدّين ونصرته ونيل الشهادة والفوز بالجنّة.
كيف أسهمت التحولات الاجتماعية والسياسية في تصاعد الأفكار المتشددة وتسللها إلى بلد مثل تونس؟
ـ سؤالكم يستبطن بعضاً من الدّهشة، وكأنّكم تقولون: كيف لبلد مثل تونس المصنّفة بلداً حداثيّاً تقدميّاً متحرّراً منذ استقلاله عام 1956وفقاً لسياسات الدولة حينها برئاسة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، كيف لبلد أصدر مجلة الأحوال الشخصيّة مباشرة بعد الاستقلال، كيف لبلد راهن على التعليم وخصّص لوزارته أعلى نسبة في ميزانيّته، فأنشأ كفاءات يفتخر بها في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية والثقافية والاقتصادية والإدارية وغيرها، كيف لمثل هذا البلد أن "يتسلّل إليه" الفكر المتطرّف؟ وهذا أمر غريب فعلاً، لكن يمكن القول إنّ مخاضات الثورة عام 2011 أنجبت فيما أنجبت مثل هذا الفكر الشّاذ عن خصوصيّات المجتمع التونسي المتّسمة بالوسطية والاعتدال في علاقتها بالمسألة الدينية، فقد وجد مثل هذا الفكر حاضنته من الجانب السياسي في فترة الانتقال الديمقراطي وما وسمها من اضطراب في إعادة ترتيب المشهد على مستوى مؤسسات الدولة، والأجهزة الأمنية، والأحزاب التي كانت تُعدّ بالعشرات وحتّى أكثر، وما نتج عن كلّ ذلك من فراغات سمحت بتنامي الحركات الراديكالية، وخصوصاً مع صعود حركة النهضة إلى الحكم زمن "الترويكا" وبعده، ممّا وفرّ الأرضيّة المريحة لانتشار مثل ذلك الفكر على أساس أنّ أصحاب السلطة حينها يتبنّون المرجعية الإسلامية، فبرزت الجماعات المتشدّدة على غرار "أنصار الشريعة" وتنامت "السلفيّة الجهاديّة" واشتغلت وفقاً لاستراتيجيات دعويّة على الاستقطاب وتغيير نمط المجتمع التونسي في علاقته بدينه، فانتشرت الخيمات الدعويّة حتى داخل المؤسسات التربوية، وتصاعد عدد الجمعيّات تحت مسمّيات دينية مختلفة، وانتشرت في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، مقدّمة المساعدات المادية لضعاف الحال، وشهدت مساجد تونس افتكاك المنابر عنوة في مناخ منفلت أمنيّاً، وانتشرت الكتاتيب والمدارس القرآنيّة الخارجة عن رقابة وزارة الشؤون الدينية، وعزّز انتشار ذلك الفكر لدى الشباب بالخصوص هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بارتفاع نسب الفقر والبطالة والتهميش، خاصّة داخل الولايات، فشكّل ذلك الفكر بديلاً مقدّساً يعد بنشر العدالة الاجتماعية وتطبيق شرع الله، في فترة اختلطت فيها الهويّات وتصاعدت خلالها التساؤلات، وأصبح الشباب، بمن فيهم بعض المتعلمين وحتى أصحاب الشهادات العليا، يبحثون لهم داخل كمّ القضايا عن منقذ وعن هويّة، ومع تجارب فشله المتتالية، كان الفكر المتطرف ملبيّاً من جهة لنقمته على حالة التهميش التي آل إليها، ومستجيباً من جهة ثانية لمقاييس العدالة الإلهية، على اعتبار أنّ البُعد عن الدين وعدم إقامة الدولة الإسلامية في مقابل دولة "الطاغوت"-وفق تعبيرهم- هو السبب المباشر لتردّي أوضاعه وبؤس واقعه.
إلى أيّ حد ينبغي تحميل المؤسسات الدينية والتعليمية مسؤولية الوقاية من التطرف الفكري؟ بمعنى آخر هل يمكن توجيه اللوم لجامعات عتيقة مثل الزيتونة والأزهر لتمدد الفكر الأصولي في مجتمعاتنا؟
ـ لا يمكن نفي دور المؤسسات ذات الطابع التعليمي الديني الشرعي في مكافحة الفكر العنيف والمتطرف والحدّ منه، بل إنّ دورها كبير وكبير جدّاً، وذلك لما تتمتع به من مصداقية وقدرة على توجيه الرأي العام باعتبارها، سواء في تونس أو في مصر، ترمز للعلوم الشرعيّة، فهي العارفة بها والمحافظة عليها، ومهما حاولنا فصل قضايا المجتمع عن العلوم الدينيّة، فإنّ الرأي الديني في أيّ مسألة يبقى الرأي الذي ينتظره عامة الناس ويبنون عليه مواقفهم من المسألة، وعليه فإنّ هذه القدرة على التأثير لدى تلك المؤسّسات بشرعيتها التي اكتسبتها، حتّى بعد انتقالها من حرم الجامع إلى حرم الجامعة، يمكن لها أن تكون ذات فاعلية كبرى في مكافحة الفكر المتطرف لدى طلابها بالخصوص، وذلك من خلال برامجها ومقرّراتها الرسمية، وكذلك من خلال هيئاتها التدريسية في علاقة مع الطالب، من خلال الدرس بتوّخي المناهج التحليلية النقدية، وتدريبه على التفكير وفقاً لشروطها، وبتحفيزه على إعمال العقل والتخفيف من النقليات في مقابل ذلك، واختيار المصادر والمراجع المتوائمة مع هذا التمشّي، فيرقى بذهنه إلى الجانب القيمي الإنساني المقاصدي في النصوص، أمّا عن اللوم الموجّه لهاته المؤسسات واتّهامها بأنّها قد تكون متورطة في تمدّد الفكر الأصولي في مجتمعاتنا، فهذا طبيعي ومتوقع، وذلك لارتباط ذلك الفكر المتطرف بالدين ونصوصه واستمداده لشرعيّته منه، فمن الطبيعي أن تتوجّه أصابع الاتهام للدين نفسه، ولتلك المؤسسات، خصوصاً مع ما شهدناه من مواقف وآراء وفتاوى متشدّدة وغريبة ومتخلفة، كذلك صدرت عن بعض الدكاترة والمشايخ، وفي إطار الهلع الذي أصيبت به المجتمعات بعد فقدانها لخيرة أبنائها في عمليات إرهابية خسيسة، كان المتّهم الأوّل هو التعليم الديني وأنظمته المستقلة أحياناً عن الدولة، وبالنسبة إلى جامعة الزيتونة، الحقيقة لا يمكن مقارنة التعليم بها مع الأزهر، وذلك لأنّ التلميذ التونسي يلتحق بهذه الجامعة التي هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي باختيار منه بعد حصوله على شهادة البكالوريا وختمه لجميع مراحل التعليم الثانوي بنجاح، وهو قبل ذلك كان قد تلقى تعليمه في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية وأحياناً الخاصة، والتي هي موحدة في برامجها وفي موادّها بإشراف وزارة التربية، حيث تكوين التلميذ التونسي دينيّاً هو تكوين معتدل جدّاً، يقتصر على ساعتين في الأسبوع، في حين أنّ الأزهر هو منظومة متكاملة منذ المستوى الابتدائي إلى المستوى الجامعي، ممّا يطبع الطالب والمتخرج في جميع كليّاته بتوجّه وبمرجعيّة موغلة في العلوم الشرعية. وهذه طبعاً لسست تبريرات كافية، فقد بيّنت بعض الدراسات أنّ بعض الملتحقين بالجماعات الجهاديّة المتطرفة لم يتلقوا تعليماً دينياً، بل هم من خريجي جامعات علميّة، ممّا يؤكد الحاجة إلى التعليم الديني المعتدل المتصالح مع القيم المدنيّة لعدم إحداث فراغ في التكوين يسهل معه استقطاب الكثير من الشباب نحو الفكر المتطرف.
لماذا يوظف الدين بشكل متكرر خدمة للتطرف وآليات العنف؟
ـ استحضار الدين وتوظيفه بشكل متكرّر لتبرير العنف يعود إلى ما يتّسم به هذا الأخير من خصوصيّة مقدّسة، فيقع استغلاله كوسيلة مضمونة لتحقيق أهداف وغايات مختلفة، قد تكون صراعاً سياسيّاً أو جدلاً اجتماعيّاً أو غير ذلك، فتوظيف هاته الآليّة يضمن للفاعلين، أيّاً كانوا، تعبئة الناس واصطفافهم على موقف أو رأي أو سلوك معيّن حتى لو كان متطرفاً وعنيفاً، لأنّ هذه الآليّة تتوفّر على طابع القداسة الذي يُعتبر فوق المساءلة، فمن خلالها يقع التلاعب بالمشاعر الدينية للمجتمعات وللأفراد لدعم مواقفهم العنيفة، كما أنّ بعض النصوص القرآنية، وحتّى نصوص المدّونة السنيّة، قد تُفسّر تفسيراً حرفيّاً من دون تنسيب متعلق بأسباب النزول، أو بالسّياق، أو بالخاصّ والعام من المعاني والدّلالات. فبعض الفقهاء والمفسرين يتشّبثون بمنظومة الناسخ والمنسوخ مثلاً، ليقع توظيفها توظيفاً إيديولوجياً يحافظ على هيكلة وأنظمة المجتمعات الأبويّة الذكوريّة، كما يحافظ من خلالها على معاني التكفير والعنف في مقابل كلّ معاني التسامح والرحمة والمغفرة والسلام، من ذلك مثلاً نجد اعتبارهم لبعض آيات سورة "التّوبة" ناسخة لأكثر من آية تدعو إلى حريّة المعتقد أو إلى التسامح، فتلك الآيات عندهم لا ينبني عليها أيّ أثر تشريعيّ، كقوله تعالى في الآية (5): "فإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
وقوله تعالى كذلك في الآية (29) من السورة نفسها: "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ".
فقد وقع توظيف مثل هاته الآيات لتشريع العنف تجاه المخالف أيّاً كان، في حين أنّها آيات محدودة بفترة معيّنة وبوضع خاصّ بين المسلمين والوثنيّين العرب الذين نقضوا المواثيق بينهم. وهذا طريق من طرق إسهام الخطاب الديني غير المرشَّد في التغاضي عن العنف وتبريره متمسّكاً بمصادر ومراجع تفسيرية وفقهية تبيحه بكلّ أريحية.
إذاً، كيف نقدّر تجربة الإسلام السياسي؟
ـ حقيقة كلّ تجارب صعود الإسلاميين إلى الحكم أثبتت ذلك على تفاوت بينها، وخصوصاً في مسألة الحقوق والحريّات وتشريع الدساتير، فالمرجعية الإسلامية للإسلام السياسي تفرض نفسها خاصة في إدارة قضايا الشأن العام، ممّا يجعل مفهوم المواطنة مفهوماً مهدّداً، فضلاً عن القوانين الوضعية التي تجد نفسها في كثير من الأحيان كذلك، غير متلائمة مع "ثوابت" الشريعة، ومهما حاولت قيادات الأحزاب الدينية الانسياق مع متطلبات الديمقراطية، فذلك يبقى ضرورة تقتضيها الدبلوماسية عند الاحتكاك بالحكم وإكراهاته.
أمّا عن تهديده للدولة المدنية وللديمقراطية في العالم العربي، فيمكن النظر إلى وضع سوريا اليوم، وإلى التشريعات المتعلقة بالنساء على وجه الخصوص، ففي حين أنّ فاتحة الوحي المحمدي جاءت بالأمر بالقراءة، يمنع إسلام الجماعات المتشدّدة الفتيات والشابات من ممارسة حقهنّ في التعليم، فضلاً عن سحبهنّ إلى مربّع "الحريم، فعن أيّ مدنيّة يمكن أن نتحدّث؟.
كيف يمكن مواجهة منظومة الأفكار المتشددة؟
ـ على مستوى العلاقة بالدين ونصوصه: ضرورة إقامة المعالجات النصيّة في فضاء رحب من البحث والتقصّي المُحتكم بالأساس إلى آليّة السياق، والتي من خلالها يمكن تجاوز دلالات القراءة الحرفيّة التي وقع توظيفها كمبرّر للعنف وللتطرف الفكري.
هذا إلى جانب المراجعات الفقهيّة المتأكدة لبعض القواعد الخطيرة أحياناً على غرار "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، فهذه القاعدة تنسف ما نسعى إليه من التضييق بل والتخلي عن كلّ المعاني الحرفيّة الداعية إلى تكفير المخالف مثلاً، كما في آيات سورة التوبة المذكورة آنفاً، لأنّ الغاية كلّ الغاية هي بلوغ روح الدين وجوهره من عدل وحريّة وتسامح ومساواة، وهذا ما عَنَاه الطاهر الحدّاد بقوله: "يجب التفريق بين ما أتى به الإسلام وما جاء لأجله"، فبصرف النظر عن الجزئيّات، وهي ما احتوته التفاصيل الواردة بالنصوص، فإنّ الكلّيّات هي الأبقى، لأنّها هي وحدها المستمرّة الدائمة، وفي هذا الصّدد لا بدّ من الانتباه إلى الأبعاد المنهجية المعرفية، كاعتماد سياسة التدّرج في التشريع، وكأسباب النزول والمناسبة والنسخ، فهي كلّها في اعتقادي تعلن عن بداية عهد العقل والحركة والتدبّر والاجتهاد الموكول كلّه إلى الإنسان.
العمل على التوجّه نحو القراءة المقاصديّة في التدّبر والفهم، لأنّها وحدها القادرة على تحويل مركزيّة الفهم نحو روح الدين القيميّة الإنسانيّة التي تليق بالرسالة الخاتمة؛ وبالتالي تتجاوز القراءة الحرفيّة لبعض الآيات التي نزلت في سياقات وبيئات مختلفة تماماً عن السياقات الحاليّة.
ولكن كيف للتعليم ومؤسساته المعاونة في ذلك؟
ـ على مستوى التعليم والشأن الاجتماعي: التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة البرامج التعليمية وفي كافة المستويات، بصرف النظر عمّا أصاب هذين المصطلحين من تجاوزات وفقاً لما نشهده اليوم من غطرسة للقوى الاستعماريّة.
والعمل على الحدّ من البطالة والتهميش وعدم تكافؤ الفرص، والسّعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة.
وفي الختام أودّ توجيه الشكر لـ (حفريّات) على هاته الأسئلة الحارقة، ولولا ارتباطنا بمساحة معيّنة للنشر، لكنّا توسّعنا أكثر في أجوبتنا...، دام لموقعكم التوفيق والبهاء.



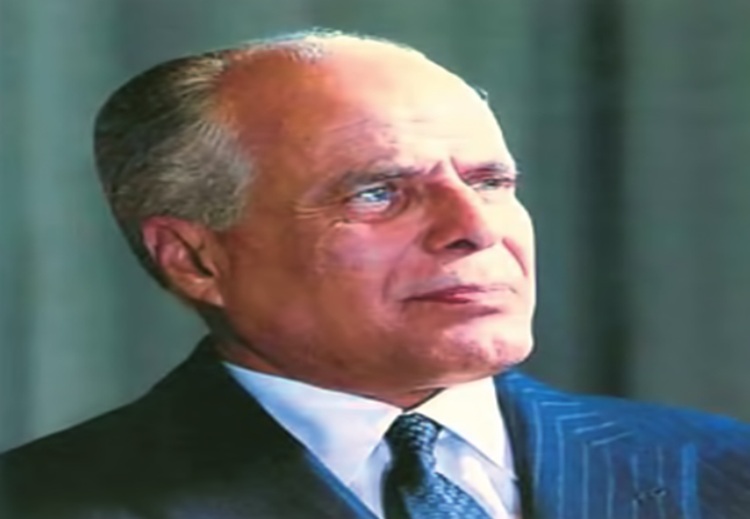
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9_0.jpg.webp?itok=9JSl_gMx)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%209999_0.jpg.webp?itok=yZ5Mfdm2)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG-20250702-WA0045.jpg.webp?itok=lVwUcevi)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=rEyWt6ea)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_28_0.jpg.webp?itok=HT2ZxCOH)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/5b085b0a15fe9_0.jpeg.webp?itok=f27vg5Eu)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20_0_0.jpg.webp?itok=QSyTIDUA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%201_0_0.png.webp?itok=53WzJ7XI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_39_0.jpg.webp?itok=_oSIrZI1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_8_0_0.jpg.webp?itok=E0FbgK-n)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_0.jpg.webp?itok=7FOOGTKJ)




![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_0.jpg.webp?itok=CG6kMAYS)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)






![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)
