
على مشارف المرحلة الحديثة إذن، كانت هناك أساليب عدة يتحدث بها الأوروبيون عن التغير والزمن والتاريخ، غير أنّ الحكم العام الذي يمكن إصداره على هذه المرحلة، هو أنّ كل ميدان من ميادين المعرفة والبحث كان يمر في نمو وتوسع سريعين، وكان هناك اتفاق عام بين جميع المفكرين والعلماء من كل الأطياف والتخصصات، على أنّ العالم مهما يكن من باقي صفاته، ليس شيئاً ثابتاً ولا ناجزاً، بل هو في كليته، وفي كل جزء من أجزائه، في تبدل ونمو وتغير وتطور وصيرورة.
ويرى (هرمان راندال) في هذا الحس العميق بأهمية الزمن، وبأهمية التبدل التاريخي، الذي يشمل كل شي، "من النجوم والذرات إلى المجتمع والعقائد والمثل العليا"، هو المزاج المشترك في الأزمنة الحديثة. أمّا إلى أين يتجه نمو عالمنا الفلكي البشري؟ وهل يصح تسمية هذا النمو تقدماً أو دوراناً أو تدهوراً؟ فهو أمر يختلف عليه الناس جميعاً، وعلى الرغم من أنّ القرن السابع عشر شغل أكثر ما شغل بتأسيس مناهج وطرائق المعرفة السليمة، بل يمكن القول إنّه قرن التاريخ الطبيعي، وشيوع طريقة العلم النيوتوني، نسبة إلى نيوتن، لكنّ حقل الدراسات التاريخية والتفكير الفلسفي في التاريخ وقواه اتسع واكتسب أبعاداً منهجية ومعرفية جديدة، وهذا ما يمكن أن نراه عند عدد من فلاسفة التاريخ، في بداية القرن الثامن عشر، أمثال الإيطالي فيكو (1668-1774م) الذي تمكن إلى حد بعيد من الإفادة الواعية من التقدم الذي طرأ على مناهج البحث والتحليل النقدي في العلوم، والمعلومات المتراكمة من الاستشراق والدراسات الأنثروبولوجية، وتوظيف كل ذلك في كتاب (العلم الجديد والطبيعة المشتركة للأمم) الذي تصور فيه تاريخاً عالماً واحداً يتحرك في (3) دورات كبرى، تحت رعاية العناية الإلهية. وتعود أهمية فيكو إلى كونه أول من تصور أنّ التاريخ يشتمل على كل الخبرة البشرية في الحضارة والثقافة والمدنية، وهو عظيم الأهمية على صعيد التأسيس المنهجي لفلسفة التاريخ.
وهكذا ينبغي أن نفهم أنّ الفلسفة، بما هي طريقة متميزة في ممارسة التفكير وإنتاج المعرفة، واحدة من أهم مصادر المعرفة وأدوات الفهم والتنوير؛ إذ يشهد تاريخ الأفكار أنّ حضور الخطاب الفلسفي الأصيل حيثما وجد عبر التاريخ، كان الشرط الرئيس لنمو وتفتح وازدهار الثقافة والأفكار الخلاقة، ونقصد بالثقافة هنا القوة الإبداعية في التاريخ، علماً وآداباً وفناً، ولا تطور ولا تقدم ولا نماء ولا ارتقاء بدون معرفة الطبيعة ومظاهرها، وفهم قوانين حركتها والتنبؤ بنتائجها، وتلك هي وظيفة العلوم الطبيعية، ولا تطور ولا تقدم ولا نماء ولا ارتقاء في التاريخ والحضارة، إلّا بمعرفة حقيقة الكائن الإنساني والمجتمع البشري، بوصفهما لحمة التاريخ ومغزى المعرفة القادرة على فهم حاجات الإنسان ودوافعه، ومقومات الحياة الاجتماعية المدنية المستقرة وقوانين التاريخ وحركته، والتنبؤ بمساراته المستقبلية، وتلك هي وظيفة العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة في قلبها، بل هي أمها التي أبدعت أخصب وأنضج المفاهيم الأساسية في تاريخ المعرفة الإنسانية: (الوجود، الإنسان، العقل، الخير، الشر، العدل، الحرية، الجمال... إلخ). وذلك منذ البواكير الأولى للفكر الفلسفي الشرقي واليوناني القديمين، مروراً باللحظة العربية الإسلامية الخصيبة، لحظة الترجمة والتفلسف في المشرق والمغرب العربي، وانتهاء بالعصور الحديثة والمعاصرة.
لم تكن الحداثة الغربية في معناها الأوسع؛ إلّا مشروعاً فلسفياً عقلانياً، قرر إعادة تأسيس وبناء المجتمع من جميع جوانبه على أسس عقلانية. وقد شكلت الفلسفة الفضاء الرحب لانطلاق وتقدم حركة التنوير الأوروبية منذ القرن السابع عشر الميلادي، وفي سياقها أزهر المنورون الكبار أمثال: فرانسيس بيكون، وديكارت، وهيوم، ولوك، وفولتير، وروسو، وديدرو، وغيرهم.
كان الألماني إيمانوئيل كانط ثمرة تيار التنوير الأنضج في مقاله "ما التنوير؟" فلا تنوير بلا فلسفة، ولا حرية بدون تفكير حر، ولا تنمية ثقافية مستدامة بدون تربية وتعليم الذكاءات المتعددة عند الإنسان؛ بما يؤهله للتفكير بعقله الخاص بحسب كانط: "أن يتجرأ كل إنسان على استخدام عقله الخاص".
ربما يعتقد البعض أنّ الانشغال بالفكر، أي بالعقل ونشاطه الفكري المجرد، هو ترف يمارسه الفلاسفة ولا طائل منه، إن لم يكن مذموماً، لا سيّما في المجتمعات العربية الإسلامية. لكن تعالوا ننظر في طبيعة هذا الاعتقاد الناجم عن الاكتفاء بالجهل المكابر. والسؤال هو بما أنّ الفلسفة هي الفكر الذي يفكر في العالم وفي ذاته، بوصفها نشاطاً عقلياً، فما الذي يحدث للعقل عندما ينطلق في حركة سهمية في رحلته لفهم العالم واكتشاف حقائقه؟ هل بقدر ما ينتهي به الأمر إلى اكتشاف "حقيقة" الأشياء، يجهل بالمقابل ذاته، أي يخسرها عبر الذوبان في تمظهرات الأشياء المادية؟ أو يعود إلينا بغنيمة الاكتشاف مضاعفاً، بوعي ذاتي بضرورة التعمق في معرفة ذاته أكثر؟ بعبارة أخرى؛ هل يغترب العقل في دروب رحلته "السندبادية لتعقل موضوعاته"؟ أم يعود، كما كان عند انطلاقته صافي السماء شاحذ الأداة؟ ولأنّ هذه العودة الغانمة، المغتنية والمغنية، هي التي لا تحدث في الغالب، فلا ريب أنّ الحاجة إلى نقد العقل وأوثانه وأوهامه هي حاجة حيوية دائمة، وذلك ينجم من طبيعة العقل ذاته، فهو ليس مهجعاً مهجوراً لتخزين المعرفة والمفاهيم، كما هو حال مخازن الأشياء والنقود والمجوهرات والبضائع.
ومن الأخطاء الشائعة، الاعتقاد بأنّ العقل هو عضو من أعضاء الجسم، إذ يتم المطابقة عند البعض بين العقل والمخ أو الدماغ، بمعنى واحد، وهذا غير صحيح. فليس هناك شيء ملموس محسوس اسمه العقل، يمكن رؤيته ولمسه بالحواس المتاحة. فالعقل مفهوم مجرد وليس عضواً مادياً متعيناً في الواقع، بل هو مفهوم يطلق على ممارسة التفكير الواعي الذي يباشره الإنسان في أثناء ممارسته لحياته اليومية، وهو أهم وأخطر المفاهيم التي مارست تأثيراً ساحقاً على حياة المجتمع الإنساني وتطوره، ويتحدد نظام كل ثقافة أو حضارة من المعنى الذي تمنحه للعقل والموقف الذي تتخذه منه، وهذا أمر يطول شرحه.
كل جيل من الأجيال معني بتدبير العيش في حاضره هو لا ماضي أسلافه، ومواجهة تحديات حاضره هو في ظل المعطيات والشروط والممكنات المتاحة في اللحظة الراهنة. والمستقبل هو أمام الناس لا وراءهم! وفي كل عصر من العصور يعاود العقل وظيفته في تأمل العالم ومحاولة فهمه من جديد عبر التساؤل المستمر ما الوجود؟ يعني من نحن هنا والآن وماذا بوسعنا فعله وكيف نعيش عالمنا الراهن؟ وأجوبة الفلسفة القديمة لا يمكنها أن تسعفنا في تفسير عالمنا الجديد وفهمه. فماذا يفيدنا قول بارميندس اليوناني: "الوجود موجود، والعدم غير موجود؟"، أو قول الفارابي: "الوجود هو الذي إذا تصورته غير موجود، نجم عن تصورك محال"، أو قول هيجل: "العقل يحكم العالم"، أو قول سارتر: "الوجود أسبق من الماهية".
إنّ كل الأجوبة القديمة جاءت لتشبع أسئلة زمانها، فهذا المؤرخ الإنجليزي المشهور (جفري باراكلاف) من جامعة أكسفورد، يكتب تحت تأثير الإحساس العميق بالأزمة: "إنّنا مهاجمون بإحساس من عدم الثقة؛ بسبب شعورنا بأنّنا نقف على عتبة عصر جديد لا تزودنا فيه تجاربنا السابقة وأسئلتها وإجاباتها بدليل أمين لسلوك دروبه، وإنّ أحد نتائج هذا الموقف الجديد، هو أنّ التاريخ ذاته يفقد، إن لم يكن قد فقد، سلطته التقليدية، ولم يعد بمقدوره تزويدنا بخبرات سابقة في مواجهة المشكلات الجديدة، التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً منذ آدم حتى اليوم". نعم من الذي ينكر أنّ العالم المعاصر شهد منذ منتصف القرن العشرين أحداثاً عاصفة، ومتغيرات متسارعة في مختلف الصعد الحضارية والثقافية والمدنية؟ متغيرات لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من حيث جدتها وسرعتها وأثرها وقوتها الصادمة للروح والعقل معاً؛ إذ بدا الأمر وكأنّ التاريخ يترنح والأرض تميد بأهلها، والقيم تهتز والحضارة تضطرب، والفوضى الشاملة تجتاح كل شيء، وبإزاء هذا المشهد القيامي المجنون تحيرت أفضل العقول، وفقد العقل الإنساني بصيرته وقدرته النيرة في رؤية الأحداث وما وراءها، ومن ثمّ تفسيرها وتحليلها والكشف عن ثيماتها العميقة المتخفية في سبيل فهمها وعقلنتها وإدراك معناها.


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/5b085b0a15fe9_0.jpeg.webp?itok=f27vg5Eu)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20_0_0.jpg.webp?itok=QSyTIDUA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%201_0_0.png.webp?itok=53WzJ7XI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9_0.jpg.webp?itok=9JSl_gMx)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_28_0.jpg.webp?itok=HT2ZxCOH)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=rEyWt6ea)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_39_0.jpg.webp?itok=_oSIrZI1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%209999_0.jpg.webp?itok=yZ5Mfdm2)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_2_0_0_0_0.jpg.webp?itok=6WBSlKFQ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_8_0_0.jpg.webp?itok=E0FbgK-n)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_0.jpg.webp?itok=7FOOGTKJ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)


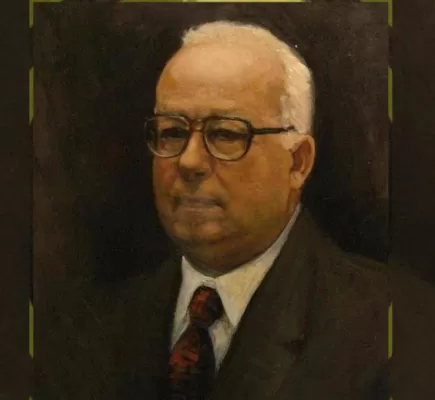


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)
