
جمال نعيم
لا يصح الكلام على ظاهرة التأدلج المختار أو الذاتي أو الطوعي في عصور ما قبل الإنترنت وتطور التكنولوجيا والفضاء الافتراضي، عندما تحولت الكرة الأرضية إلى قرية صغيرة وصار العلم متاحاً للجميع، على رغم أن بعض الأنظمة ما زالت تضيق على مواطنيها بطريقة أو بأخرى، وعلى رغم أن التقنية المتطورة ساعدت هذه الأنظمة في ذلك.
في القرنين الأخيرين كان كثير من البشر يعيشون في ظل أنظمة قمعية استبدادية أو متخلفة تعد لهم أنفاسهم وتمنع عنهم هواء الحرية. كانت تفرض عليهم نوعاً من "الستار الحديدي" فلا يطلعون إلا على ما تريد السلطات أن تطلعهم عليه ولا يفعلون إلا ما تستحسنه. حتى العلوم والفلسفة كانت تحرف وتزيف لتنسجم والأيديولوجيا المهيمنة. هكذا كانت تتم أدلجة الجماهير وسجنها وقولبتها في قوالب فكرية وأيديولوجية جامدة، فيتعود "المواطن" ذلك النهج، بل يستحسنه أحياناً كثيرةً ويحسبه أمراً عادياً طبيعياً. بذلك تتحول الأيديولوجيا إلى سلاح فتاك، لا سيما عندما تزين لمعتنقيها فعل الإجرام. صحيح أن لا مجتمع من دون أيديولوجيا تروم تعبئة الجماهير وتحريكها في اتجاه معين. لكن من الخطير أن تلجأ الأيديولوجيا إلى تزييف الوعي وتخديره، فلا تسمح بأي نوع من النقد الفلسفي حتى لو كان نقداً بناء.
ماذا نعني بالتأدلج المختار؟
ما تحدثنا عنه وحذرنا منه هو الأدلجة التي تمارسها السلطات بأجهزتها القمعية الخشنة وأجهزتها الأيديولوجية الناعمة. لكن ما يلفت الانتباه، اليوم، هو ظاهرة الأدلجة الذاتية أو الطوعية، إذ ينسلك الإنسان، طواعيةً وبملء إرادته، في نوع من الصيرورة-أدلوجاً أو التأدلج، من دون توجيه مباشر من السلطات ووسائل الإعلام ومن دون تدخل عنيف من أجهزتها، وإن كان ذلك يناسبها في كثير من الأحيان. إذاً، إن التأدلج المختار من الأمراض الثقافية الحديثة، كما نقول إن داء السمنة لم تعرفه المجتمعات القديمة، إذ لا يمكن من يعاني الفقر وسوء التغذية أن يصاب بداء السمنة. الأمر كذلك مع التأدلج الطوعي، إذ لا يمكن من لم تتح له المعرفة بأنواعها أن يخضع له.
ازداد الأمر سوءاً بعد سيطرة التفاهة، بحيث كثر التافهون الذين تكتلوا في مجموعات افتراضية تافهة انتمت إلى قطيع افتراضي يتعاظم باستمرار. هكذا صار التأدلج مطلباً مريحاً على رغم انتشار التعليم وعلى رغم أن الكتب صارت في متناول الجميع. بذلك يستقيل العقل، ويتدجن صاحبه، ويستسلم للجبن والكسل، ويركن إلى الراحة، ويقتل كل فضول معرفي لديه. فيتقولب، ذاتياْ وطوعياً، في قوالب جامدة نهائية. وعليه، فإن ما نعالجه اليوم هو الأدلجة الذاتية أو التأدلج المختار، وذلك عندما يختار الإنسان بملء إرادته، مهما كان متعلماً وحاصلاً على شهادات عليا ومهما كان منفتحاً على العالم وكثير السفر والترحال، أن يؤدلج نفسه بنفسه وأن يعيش في قالب فكري أيديولوجي ضيق، مع أن المعرفة والفلسفة والعلم والثقافة حقولٌ متاحةٌ للجميع. يختار أن يعيش في "الخسة" كما يقال. هكذا نجد أناساً على درجة عالية من العلم، تعلمت في أرقى الجامعات العالمية وعاشت في أكثر البلدان تقدماً، ومع ذلك لا تتميز من إنسان بسيط غير متعلم يعيش في إحدى القرى النائية. كيف لهذه الجماعات أن تتأدلج وتتقولب بملء إرادتها في قوالب أيديولوجية جامدة؟
ومن ثم، نجد أن هذه الجماعات لا تستفيد مما تعلمته في المدارس والجامعات ولا مما حصلته من تجارب في الحياة ولا مما أفادته من سفرها وترحالها في بلاد الله الواسعة. لقد استحسنت العيش في أكواخ أيديولوجية على رغم ما تعيشه من تطور تكنولوجي مذهل، يصاحبه انتشارٌ واسعٌ للتعليم وهيمنةٌ متعاظمةٌ للفضاء الافتراضي.
الستار الحديدي الذاتي
من عقود خلت كنا نسمع بالستار الحديدي الذي كانت تفرضه بعض الدول على مواطنيها. اشتهر بذلك مثلاً الاتحاد السوفياتي الذي كان يفرض على شعوبه وشعوب الدول الاشتراكية التي كانت تدور في فلكه ستاراً حديدياً قاسياً حتى لا تتأثر شعوب هذه الدول بالدعاية الرأسمالية "الشريرة" وتخطئ مصلحتها فتتخلى عن الاشتراكية التي كانت تؤسس على ما كان يدعى "الماركسية العلمية". يمكن القول إن كوريا الشمالية ما زالت تعيش ضمن ستار حديدي لا مثيل له.
إذاً، قبل تطور التكنولوجيا وولادة العصر الافتراضي أو العمومي، كان بإمكان السلطات المحلية أن تؤدلج مواطنيها وتدجنهم فلا يشاهدون إلا محطةً تلفزيونية واحدة ولا يقرؤون إلا الصحف التي يصدرها الحزب الحاكم ولا يستمعون إلا إلى الإذاعة الرسمية. كان الديكتاتور في الأنظمة القديمة يبذل، والحال هذه، جهوداً جبارةً لمنع مواطنيه ورعاياه من الاطلاع على ما يجري في العالم. لكن على رغم ما نعيشه، اليوم، من انفجار المعرفة، وانتشار التعليم والمدارس والجامعات، وانحسار الأنظمة الديكتاتورية، تبرز ظاهرة استقالة العقل طوعياً من التساؤل والتفكير وطرح المسائل وصوغها والتنازل عن كل فضول معرفي، أي تبرز ظاهرة التأدلج المختار أو الطوعي. وذلك عندما يختار البعض بملء إرادتهم العيش في ظل ستار حديدي ذاتي طوعي يفرضونه على أنفسهم. هكذا نتفاجأ بأشخاص حقيقيين وأصدقاء افتراضيين على مستوى عال من العلم والمعرفة، نعرفهم حق المعرفة، ومع ذلك نجدهم مؤدلجين بالكامل ومصفحين جيداً ضد الوعي.
وعليه، بإمكاننا القول إن الأزمة التي نتحدث عنها هي أساساً أزمةٌ في العقل المستقيل الذي لم يعد يجرؤ على التفكير، وأزمةٌ في الفكر المدجن الذي قضى على حب الاطلاع لديه. من هنا وجوب الفلسفة. فالفلسفة فن إبداع الأفاهيم إذا ما نظرنا فيها بوصفها طريقةً مختلفةً في التفكير، وفن النبالة أو فن الحياة النبيلة إذا ما نظرنا فيها بوصفها نمط حياة وأسلوب عيش وفن وجود نبيلاً. غايتها فضح الممارسات السافلة ومهاجمة البلاهة والحماقة.
ما يدفع إلى الفلسفة اليوم ليس فقط الاندهاش أو الشك أو التشوش، بل أيضاً الابتذال والخسة في الفكر والثقافة وأنماط الوجود. ومع ذلك، فإن دوافع الفلسفة هذه لا تستفز عقل المؤدلج ذاتيا أو طوعياً فيغرق في الصيرورة-أدلوجاً حتى يتصفح ذهنه بإحكام ضد كل أنواع الوعي.
الكسل والجبن
إن فعل التفلسف خطير، بل وخطيرٌ جداً، يقض مضاجع السلطة الدينية والسياسية معاً. الفلسفة مغامرةٌ فكرية ومجتمعية وشخصية ولغوية عظيمة لا يقوى عليها كثيرون، بل غالباً ما لا ينسلك فيها كثيرون بسبب من الكسل والجبن اللذين يعانونهما. إنها تغير في الفرد المتفلسف وفي المجتمع الحاضن التفلسف. في هذا السياق، يقول كنط في مقالته الشهيرة: "ما الأنوار؟": "إنها خروج الإنسان من قصوره الذي هو مسؤولٌ عنه. قصورٌ يعني عجزه عن استعمال عقله من دون إشراف الغير، قصورٌ هو نفسه مسؤولٌ عنه لأن سببه لا يكمن في عيب في العقل، بل في الافتقار إلى القرار والشجاعة في استعماله من دون إشراف الغير. تجرأ على استعمال عقلك: ذاك هو شعار الأنوار. إن الكسل والجبن هما السببان اللذان يفسران بقاء مثل هذا العدد الكبير من الناس مرتاحين إلى قصورهم مدى الحياة، بعد أن حررتهم الطبيعة من زمن بعيد من التوجيه الخارجي. كذلك يفسران كم من السهل على البعض أن ينصبوا أنفسهم أوصياء على هؤلاء". هذا ما يناسب المؤدلج ذاتياً الذي يدجن ذاته ويقتل الفضول المعرفي لديه.
حتى تاريخ الفلسفة يمكن أن يتحول أحياناً إلى عامل من عوامل الأدلجة الذاتية والتأدلج، فيحول دون حرية التفكير في حال لم نحسن التعامل معه. في هذا الصدد، يقول دلوز: "كان تاريخ الفلسفة دائماً عاملاً سلطوياً في الفلسفة وحتى في الفكر: لقد لعب دور المضطهد: كيف تريدون التفكير من دون قراءة أفلاطون ودكارت وكانط وهيدغر، وكتاب فلان أو علان عنهم؟ مدرسة تخويف رهيبةٌ تصنع اختصاصيين في الفكر، لكنها تؤدي أيضاً إلى أن يمتثل من يبقون خارجها بشكل أفضل، إلى هذا الاختصاص الذي يستهزئون منه. تكونت عبر التاريخ صورةٌ للفكر، تدعى الفلسفة تمنع الناس تماماً من التفكير". يمكن القول إن صورة الفكر تعبر عن توجهات الفكر واتجاهاته، وهي بمنزلة خريطة طريق للفكر لا يفكر من دونها. لذلك من الأفضل أن نبحث عن الجواهر الفكرية الثمينة عند جميع الفلاسفة.
مقولات السلطة بحسب فوكو
تعمل السلطة، بحسب غرامشي، إما عبر القمع وإما عبر الأيديولوجيا، أي تعمل إما عبر أجهزتها القمعية من جيش وشرطة وأجهزة أمنية، وإما عبر أجهزتها الأيديولوجية من مدرسة وجامعة وإعلام. لكن لفوكو رأيٌ آخر. يهمل فوكو سؤال ما السلطة؟ ليهتم بسؤال آخر: كيف تمارس السلطة؟ فالسلطة ميزان قوًى [صلة بين قوى]. إنها صلة وعلاقةٌ بين القوى. ليس للقوة من موضوع آخر غير قوى أخرى، مع أن ميزان القوى لا يعمل بالعنف. يقول دلوز: "إن فوكو أقرب إلى نيتشه (إلى ماركس أيضاً)، الذي يرى أن ميزان القوى يتعدى العنف، ولا يمكن أن يعرف به. ذلك أن العنف يتناول أجساداً، موضوعات أو كائنات متعينةً يبيدها أو يغير شكلها، في حين أنه ليس للقوة من موضوع آخر غير قوى أخرى ولا كينونة أخرى غير الصلة [...]. يمكننا إذاً أن نتصور لائحة، مفتوحةً بالضرورة، من المتغيرات التي تعبر عن ميزان القوى أو السلطة، وتؤلف أفعالاً في أفعال: حرض، أثار، بدل الاتجاه، سهل أو صعب، وسع، ضيق، زاد في الاحتمال أو أنقص منه... تلك هي مقولات السلطة". مقولات السلطة هذه هي ما يبطل القول بالأجهزة الأيديولوجية والأجهزة القمعية، إذ إن السلطة تحرض وتثير وتبدل وتوجه بشكل غير مباشر أكثر مما تقمع وتغسل الدماغ. هذا ما يسهل التأدلج الطوعي الذي يختاره البعض من دون أن يشعروا بأن السلطة تريد لهم ذلك.
لماذا تفشل المدرسة والجامعة في تكوين العقل العلمي النقدي عند الطالب؟
أقصى ما يستطيع التعليم العلمي أن يبنيه في الدولة هو الحداثة المادية الشيئية. أما الحداثة القيمية الفكرية التي تبني الإنسان وتتجسد في دولة حديثة ذات قيم ومؤسسات راسخة، فلا تبنيها سوى الفلسفة وأخواتها. لذلك نطالب بإدخال مواد فلسفية وسياسية في جميع الاختصاصات الجامعية. أن يختار الطالب قسم الفلسفة، فهذا لا يعني أنه ملوثٌ بلوثة الفلسفة، كما لا يعني أنه يميل إلى التفكير من دون وصاية. غالباً ما يختار المؤدلج قسم الفلسفة لا ليتعلم الفلسفة الحق ويتمرن على التفكير النقدي، بل ليدعم أيديولوجيته ويخدمها. لذلك يصعب عليه أن يكون مستنيراً. ذلك بأنه لا يطيق التفكير الحر ويمتنع عن التفكير في أساسات أيديولوجيته لأنه ينشد الراحة والسلام والاطمئنان، لا الحقيقة.
رأس الكلام أنا نعاني من ضعف في التثقيف السياسي وغياب للتفكير النقدي. إن حرية التفكير تبدو عند كثيرين كأنها أمرٌ هامشي وثانوي وليست من مستلزمات الحياة البشرية. لذلك يتنازل عنها المؤدلج ذاتياً طواعيةً حتى لو نال أعلى الشهادات في الفلسفة. وهذا ما يدفع في اتجاه العبودية الفكرية المختارة. نختم بالقول إن الفلسفة تفكيرٌ من دون وصاية وإثباتٌ للحياة وتعزيزٌ لها، ولا معنى لها إن لم تكن كذلك.
اندبندنت


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_3.jpeg.webp?itok=z6mKHJ6k)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_35_1.jpg.webp?itok=oKkzjRnd)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/news-200622-syria.qsd__0.jpg.webp?itok=U7FQqoQQ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_0_0.jpg.webp?itok=9wDTP4M1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/113-222213-new-brotherhood-terror-egypt_700x400_0_0.jpg.webp?itok=RAnr6jDw)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_0.jpg.webp?itok=b05Ol8kv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8_0_2.jpg.webp?itok=LxbaeJOC)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%862_5_0.jpg.webp?itok=qXRkrlF1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_12_2_0_0_1_0.jpg.webp?itok=TMEBXkE4)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9_0_1_0_0_0_0_0_0_1_0_0_0.jpg.webp?itok=hfeHRDlN)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/tjnyd_0_3.jpg.webp?itok=ULMfdfQi)
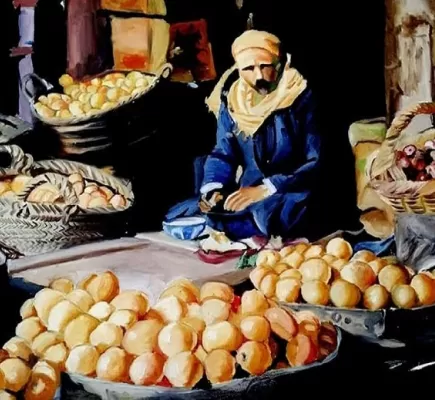

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%85_2_0_0.jpg.webp?itok=3Js0TkZH)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/AR_20250313_080615_080805_CS.jpg.webp?itok=_rwY1gWU)


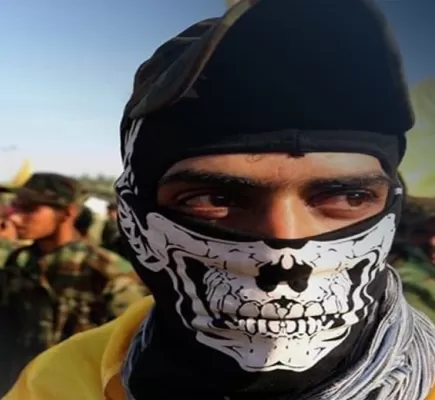




![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_22_2_0.jpg.webp?itok=mAF6t0TM)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)
