
من أعمق نقطة في وجدانه، أيقن ماركس أنّ الحياة هي أعزّ شيء لدى الإنسان، وأنّها يجب أن تعاش عيشةً لا يشوبها استعباد، ولا يشوّهها الإحساس الممض بالخطيئة والذنب، أو الرعب المهووس بالعذاب. ومثلما كانت حياته منذورة بالكامل للنضال من أجل تحرير الإنسانية من كافة قيودها، وهاجسه اليتيم هو أن يصبح العالم مختلفاً عن الذي لدينا الآن وأفضل، فقد أمل أن تكون حياة كلّ المشغولين بالهمّ الإنساني كذلك.
ضدّ المجتمع قبل الدين
مثل رواد علم الاجتماع الكبار، تناول ماركس بالتحليل والدرس ظاهرة الأديان في المجتمعات الحديثة، على هامش دراسته للحداثة بأوجهها كافة: الاقتصادية/ الرسمالية، السياسية/ الديمقراطية، ونقيضها البونابرتية، الثقافية/ العلمانية، وكان ماركس أول نظرائه في التنظير للوعي التاريخي للشعور بالقطيعة مع الماضي، وتشكيلاته الاجتماعية وأيديولوجياته؛ وهو ما وضعه في مواجهة سياسية وفلسفية مع الظاهرة الدينية.
مثل رواد علم الاجتماع الكبار تناول ماركس بالتحليل والدرس ظاهرة الأديان في المجتمعات الحديثة لدى دراسته للحداثة بأوجهها كافة
كان ماركس يطمح للكشف عن القوانين والأنساق التي تنتظم الحياة الاجتماعية وفقها، وفي هذا وجد نفسه في صدام لا يمكن تفاديه مع الدين، بوصفه تمثيلاً وبناءً رمزياً لفهم العالم؛ فأساس مشروعه النظري الكبير تطلّب تفسير الحياة الاجتماعية، ليس من خلال المفاهيم والرموز التي يستخدمها الفاعلون الاجتماعيون، وإنما من خلال الشروع في التحليل النقدي المنظم للتفسيرات التي يقدمها أولئك الذين يشتركون في الحياة الاجتماعية لأعمالهم ولأوضاعهم، وللخبرات التي يتقاسمونها، والتي يعدّ الدين وجهها التلقائي أو التقليدي، وفق دانييل هيرفيه وجان بول ويلام، في كتابهما "سوسيولوجيا الدين" 2005.
ولعلّ من شأن التفحّص النقدي لأهمّ بيان مباشر لماركس حول الدين، في الصفحات الأولى من "مقدمة في الإسهام في نقد فلسفة الحقّ عند هيغل"؛ أن يوضح أنّ نقد الدين شكّل جسراً للعبور النظري إلى الموضوعية في تفسير الواقع الاجتماعي، وزحزحة الطموح الجبّار للأديان لإعطاء معنى شامل للعالم؛ إذ يقول: "بالنسبة إلى ألمانيا، فإنّ نقد الدين قد اكتمل بشكل أساسي، ونقد الدين هو الشرط المسبق لكلّ نقد".
في مقاله التأسيسي "الماركسية والدين: أكثر من أفيون"؛ يحدّد جون مولينو قصد ماركس بكلامه هذا بالعمل المشترك بين الثورة العلمية والتنوير (الموسوعيون الفرنسيون خصوصاً)، ونقد الكتاب المقدّس من قبل اليسار الهيغلي العلماني في ألمانيا، هو من قام بإجهاض طموحات المسيحية في تقديم صيغة واقعية ودقيقة للطبيعة وللتاريخ؛ بل ولاهوت متماسك ومتّسق.
المسألة اللافتة، التي لم ينتبه إليها مولينو، والتي تطرحها على أذهاننا عودة الدين في المجتمعات المتخلفة والحديثة على حدّ سواء، هو تغلغل الطموح العلماني في طرح ماركس والمتعلق برهان العلمانية الكبير على الزوال المطرد للدين من الحياة الاجتماعية للمجتمعات الحديثة؛ فقد ارتكزت مجمل أطروحاته حول الدين على التراجع البادي لتأثير المعتقدات والمؤسسات الدينية في الحياة الحديثة.
وتوضح جملة ماركس هذه؛ أنه عدّ نقد الدين أمراً مفروغاً منه، ودحضه أمراً ناجزاً، فلم يركّز طاقته على النقد التفصيلي للدين؛ بل انتقل سريعاً إلى هدفه الرئيس: نقد المجتمع الذي ينتج "الوهم الديني"؛ فالإنسان، في تحليله، هو الذي ينتج الدين، وليس الدين هو الذي ينتج الإنسان، أو بحسب تحديده في "الأيديولوجيا الألمانية"، مع رفيقه إنجلز: المجتمع والدولة هما من ينتج الدين كوعي معكوس للعالم، أو كمنطق للعالم في صورة شعبية؛ ولذلك فإنّ الصراع ضدّ الدين هو بصورة غير مباشرة صراع ضدّ هذا العالم الذي يمثّل الدين شذاه الروحي".
الدولة الدستورية الحديثة لا تلغي الدّين وإنما تجعله أمراً متعلقاً بالمجال الخاص وتعيد تنظيمه وتتدخّل فيه بموجب سلطتها السياديّة
في هذا الطرح؛ تتّسم بلاغة ماركس بالتراوح بين الذمّ والمدح؛ فـ "الدين هو الإنجاز الرائع للكائن البشري؛ لأنّ هذا الكائن لا يمتلك واقعاً حقيقاً"، وهو استجابة للاغتراب الإنساني، اغتراب الإنسان "الذي خسر نفسه"، وهو ما ينطبق على تطرقه إلى الوظيفة الاجتماعية للدين، إذ يقول: "الحاجة إلى الدين هي، في جانب منها، تعبير عن الحاجة إلى الواقع، ومن ناحية أخرى احتجاج على الخطر الواقعي. الدين هو حسرة الإنسان المضطهد المظلوم، وهو روح عالم بلا قلب، وروح الظروف الاجتماعية التي استبعدت الروح".
هنا لا ينفي ماركس أنّ في الدين عزاء للإنسان في العالم، وسعادته التي ربما قد تكون الوحيدة، لكنّه اعتبرهما: عزاءً زائفاً وسعادة وهمية؛ وبالتالي اعتقد أنّ إلغاء هذا النوع من العزاء وهذا الشكل من السعادة هو الشرط الأول لخلق سعادة حقيقية، أو في كلمة: بدلاً من إلغاء الوهم يجب إلغاء الوضع الاجتماعي الذي يحتاج إلى وهم من أجل القدرة على البقاء فيه، وبذلك انتقل ماركس من نقد السماء إلى نقد الأرض، أو من نقد الدين إلى نقد القانون، ومن نقد العقائد إلى نقد السياسة.
اقرأ أيضاً: كيف شخّص ماركس علاج اغتراب الإنسانية؟
إذاً؛ كان نقد الدين في النصّ الماركسي ذا صيغة مزدوجة؛ فهو أساسي كنقطة انطلاق مبدئية لتحليل البنية الاجتماعية، وثانويّ لأنّه لا يتم إلا عبر تحليل المجتمع الذي ينتج الاغتراب الديني والسياسي والوجداني، لكنّه في الحالتين لم ينظر إلى الدين كواقع قائم بذاته، ولم ينصت مرة إلى منطقه الخاص، وإنما كناتج عن ظاهرة الاغتراب، ولم يكن مهمّاً بالنسبة إليه إظهار عدم واقعية الدين؛ بل كشف علاقته البنيوية بالتمزق الإنساني الذي لا يمكن التغلب عليه إلا عبر القضاء على الاختلال القائم في نمط الإنتاج بين مَن يملك ومَن يعمل.
متى كان أفيوناً؟
كان إيمانويل كانط أول من استعمل لفظة "أفيون" كمجاز للتعبير عن الدين في كتابه "الدين في حدود العقل البسيط"، إذ يقول: "إذا تدخّل القسّ لحظة الموت، بصفته مواسياً ومعزيّاً، يطمئن الوعي الأخلاقي أكثر من إثارته وإيقاظه؛ فإنّه بذلك يقدّم الأفيون إلى الوعي بشكل ما"؛ وبالتالي كان الفارق الذي أحدثه ماركس يتعلق بحديثه عن الشعوب وليس الفرد؛ مسجّلاً بذلك أوّل نقد للدين من منظور سياسي، وهو شيء جديد حتى على الاشتراكيين أنفسهم؛ فقد كانت الاشتراكية قبل ماركس مهادنة بشكل مبدئي للدين، وكان الاشتراكيون يجاهرون بمشاعر ذات طابع إيماني لافت.
ما سبق، أصبح من سقط متاع الوعي بالاشتراكية، لكنّ السؤال الذي لم يُطرح بعد: لماذا كان ماركس بالذات أول من بادر لنقد الدين سياسياً، وخسر بذلك دعم الاشتراكيين الفرنسيين؟ يوضح الظرف التاريخي الذي سجّل فيه ماركس موقفه النقدي من الدين الكثير عن نظرته العدائية تجاهه؛ إذ جاءت كتاباته في لحظة سياسية شهدت فيها بلاده بروسيا تشابكاً بالغ التعقيد بين الدين والسلطة، وانخرطت الكنيسة اللوثرية في إضفاء الشرعية على السلطة والوضع الاجتماعي القائم.
وقد يفسر هذا اتساع نطاق معركته مع الدين، فهو لم يكتفِ بنقد الظاهرة فحسب؛ بل صبّ جام هجومه على كلّ الاشتراكيات التي تستلهم الدين، أو تجمع بينه وبين الشيوعية في مُركب ثقافي واحد، وتلك التي تعتبر المسيح أول ثائر عرفته الذاكرة البشرية، ولربما كانت صيحة الحرب الصاخبة، التي أطلقها في البيان الشيوعي، بمثابة الردّ السياسي الحاسم على شعار الاشتراكية المسيحية: "كلّ البشر أخوة"، لكن سيكون من قبيل عدم الإنصاف اختزال نقده في جانبه السياسي وحده؛ فهو محمّل برؤية فلسفية ترى فيه اغتراباً للإنسان، أنتجته طبيعة علاقات الإنتاج السائدة.
بخبرته التاريخية، كان ماركس رافضاً لأيّة مبادرة إصلاحية من ممثلي المسيحية ترمي لتخفيف حدّة البؤس عن الطبقات الفقيرة، على اعتبار أنّ المسيحية أخذت فرصتها التاريخية كاملةً على مدار 18 قرن، لم تقدم فيها للمحرومين شيئاً يُذكر؛ بل رأى في هذا النوع من المبادرات محض مجاراة انتهازية للمدّ الاشتراكي، يقول ماركس في نوعٍ من جرد حساب للمسيحية: "الحاجة للدفاع عن اضطهاد وقمع العمال، حتى لو كانت تقوم بذلك بإظهار القليل من الألم".
وبالحديث عن المسيحية يجدُر تذكُّر أنّ ماركس كان رائداً في إظهار ميل المسيحية إلى قيم الضعف واحتقار الذات، وهي الإدانة التي طورها نيتشه في "نقيض المسيح" لاحقاً، إلا أنّ إدانته على عكس نتيشه ليست فلسفية بحتة، بل كانت جزءاً من مخطط إستراتيجي يهدف لعزل العمال عن التأثيرات السلبية المحتملة للنزعة الدينية على أي مشروع ثوري وإبطائه وعرقلته وإفراغه من مضمونه، يقول ماركس: "تبشّر المسيحية بالتخاذل والمهانة، احتقار الذات، الإذلال، الخزي، الهوان، العبودية، باختصار: بكل صفات النذالة والتحقير [الذاتي]؛ لقد برّرت [المسيحية] العبودية في العصور القديمة، وعظّمت من [شأن] قنانة ورِقّ العصور الوسطى، وإنّ البروليتاريا، التي لا تريد أن تعامل نفسها باحتقار في حاجة إلى شجاعتها، الشعور بكرامتها، اعتزازها بنفسها وبروحها في الاستقلال أكثر من حاجتها إلى الشعور بالألم".
ويمكن ببساطة استخلاص أنّ الرؤية الضمنية لماركس تفترض مبدئياً أنّ الدين (والمسيحية بالتحديد والتعيين) محافظ بالضرورة بحكم الافتراضات الفلسفية المتضمنة فيه، وفي هذا يمكن القول إنّ ما أخذه ماركس على هيغل في حواره السياسي معه، بأنّه يعطي صكّ وضمانة الديمومة على وضع تاريخي، أوقع نفسه فيه؛ فالتعبيرات الدينية، كما اتضح مع لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية في القرن العشرين، تظلّ عوامل محتملة للانعتاق وتحرير الشعوب.
لاحظ ذلك الفيلسوف الماركسي، ميشيل لووي، الفرنسي/ الأرجنتيني، والمنشغل بلاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية، في مقال بعنوان "أفيون الشعوب؟ الماركسية النقدية والدين"، 2005؛ حيث دعا إلى الاستعانة بأرنست بلوخ، الذي وإن كان يتماسّ مع رأي ماركس تجاه الظاهرة الدينية، ذات الطابع المزدوج: القمعي والتمردي، إلا أنّه رأى في "الصيغ التمردية والاحتجاجية للدين أحد أهم الأشكال للوعي الطوباوي، وأحد أغنى التعبيرات عن مبدأ الأمل وأحد المتخيلات القوية لما لم يقم بعد" على عكس ماركس؛ الذي أقرّ بالدور التمردي للدين، لكنّه رآه ظاهرة من الماضي لم تعد لها أهمية في عصر صراع الطبقات الحديث.
لم ينظر ماركس إلى التأويلات التقدمية المحتملة للدين، لكنّه كان على حقٍّ تاريخياً؛ فمنذ ظهور المجتمع الصناعي دافعت الكنيسة عن "القانون الإلهي لعدم المساواة"، وحين اعترفت ببؤس العمال حثّتهم على ألا يحصروا آمالهم فوق الأرض فقط؛ وبالتالي دعتهم عملياً إلى التخلي عن المقاومة والرفض والاحتجاج، أو بكلمة: سلبتهم الحقّ في الثورة وأعطتهم "أفيون الوعي".
على ضفة السياسة؛ عمّق إلحاد ماركس، في صورته بالغة الحدّية، النزعة المحافظة لدى جزء مؤثر من ممثلي الكنيسة، وأشعرهم بتهديد وجودي إزاء أطروحاته المعادية للدين، بل، بوجهٍ ما، جعلهم معادين للحداثة نفسها، التي تجلب هذا النوع من الدعوات الخطيرة.
جدل الدين والدولة
على ضوء سياسات الدولة الألمانية المسيحية، في القرن الثامن عشر، كتب ماركس "حول المسألة اليهودية"، ورغم أنّ الوضع كان تجريبياً بامتياز، إلا أنّ ملاحظاته ما تزال تتمتع براهنية مدهشة، يقول فيها: إنّ "سلطة الدين هي دين السلطة"، وإنّ "الدولة الدينية تظهر تعاملاً سياسياً تجاه الدين وتعاملاً دينياً تجاه السياسة"، في اللحظة الراهنة؛ يمكن الاستفادة من استبصاره هذا في فهم السياسات الإيرانية تجاه الدين وتسييسه، وتجاه المجال السياسي الداخلي، الذي تمّ تديينه، حتى بات حبيساً للمعايير الدينية، وأجبر الفاعلين السياسيين على تبني خطاب ديني، وإلا تمّ استبعادهم من حقل التأثير في المجتمع.
وحول علمانية الدولة؛ قدّم ماركس ملاحظة بالغة الأهمية تفيد بأنّ "تحرّر الدولة من الدين يحرّر الإنسان سياسياً؛ باستبعاده [الدين] من الحقّ العام إلى الحقّ الخاص"، إلّا أنّ ذلك ليس كافياً في نظره؛ لأنّه "يترك الدين كظاهرة فردية تفصل الإنسان عن الإنسان، وتفصل الحياة الفردية عن الحياة العامة"، فتزدهر الهويات الدينية بدلاً من أن تختفي.
قدّم ماركس نقداً لامعاً للرؤية العلمانية التبسيطية، التي تلحّ على ضرورة حياد الدولة تجاه الدين، وأن تجعله غير ذي صلة بمكانة المواطنين المدنية والسياسية (حتى لا تتشكّل أيّة معارضة دينية للدولة)، فحاجج بأنّه من الخطأ الاستنتاج أنّ التسيّس ينتزع عن الدين؛ فإنه بذلك يصبح غير متصل بالحياة السياسية، وشدّد على أنّه بسبب نزع التسيس هذا، ورغماً منه، فإنّ الفروقات الدينية ستزدهر مثل باقي الفروقات الاجتماعية: العرق، الطبقة، المكانة، وأنه بمجرد زحزحة الدين إلى مجال الخصوصية سيصبح روح المجتمع المدني بعد أن كان روح الدولة؛ وبالتالي سيصبح الأساس الثقافي للهوية الفردية والجماعية.
ما يحدث باختصار، كما لاحظت صبا محمود في كتابها "الاختلاف الدينيّ في عصر علمانيّ: تقرير حول الأقليّات" 2015؛ أنّ "الدولة الدستورية الحديثة لا تلغي الدّين، وإنما تجعله أمراً متعلقاً بالمجال الخاص، وتعيد تنظيمه، وتتدخّل فيه بموجب سلطتها السياديّة، وبالتالي بدلاً من أن تمحو السياسات العلمانية الفروق الدينية، فإنّها تنتج التفاوت الديني"، ويمكن اعتبار التاريخ الاجتماعي لتركيا ومصر دليلاً عملياً على واقعية استبصار ماركس هذا.
مواضيع ذات صلة:
- روجيه غارودي: الإسلام والمسيحية والماركسية في قلب واحد


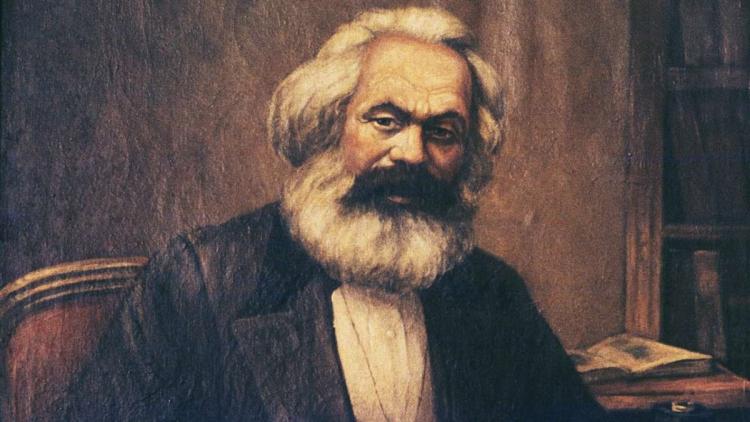



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A_24_2_1_0_0_0.jpg.webp?itok=9RUG5bq0)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/Almawqea2025-07-01-03-50-49-397650.jpg.webp?itok=QMUPc86w)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_94_0.jpg.webp?itok=h9IzVUjE)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8688_0_3_1_7_7.jpg.webp?itok=_Ei2Emc-)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/264205_3.jpg.webp?itok=S_ZzoLef)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B8_1.jpg.webp?itok=OFwnxSCn)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%840.jpg.webp?itok=QXm-QoHN)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/macron-sisi_0_0.jpg.webp?itok=lPFzOQpK)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_44_0.jpg.webp?itok=EfRcINOU)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_0.jpg.webp?itok=CG6kMAYS)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_85_0.jpg.webp?itok=KEN7a-8y)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_70_0_2_1.jpg.webp?itok=xPJQaPu3)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/91390-revolutionswaechter_khamenei.jpg.webp?itok=pAsOmTB1)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)
