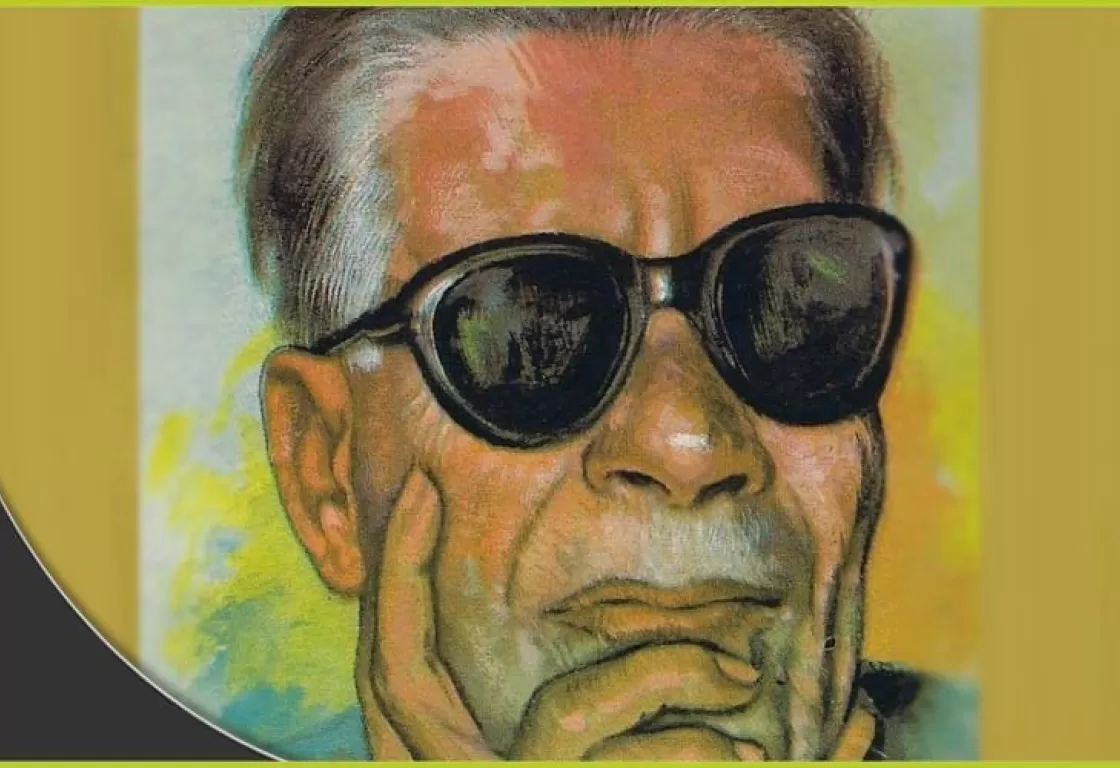
"في البدء كان الظلام
أي نوم هذا الذي غلبك وتمكن منك
لقد طواك ظلام الليل فلم تعد تسمعني"
ربما سافرت تلك الكلمات من ملحمة جلجامش عبر الزمان قبل أن تستقر على ضفاف النيل في إحدى قرى صعيد مصر، بينما الصغير الذي فقد بصره وهو في سن الثالثة يلتمس بين الدروب الضيقة سبيلاً للحياة، في حين اختزنت ذاكرته بعضاً من صور الماضي القريب قبل أن يطوي الظلام كل شيء من حوله.
في سيرته الذاتية "الأيام"، يرتّب طه حسين عناصر الوجود الحسية في عناية فائقة، ربما يفتقد إليها المبصرون، نراه يصف حقول القصب الممتدة على مدد الشوف، وكيف تنجح الأرانب في تخطّيها وثباً أو انسياباً بين قضبانها، ويمضي متشبثاً بذكرى العالم المضيء التي غدت موضوعاً للإدراك، في وجود بات يتسع كلما سار بعيداً، ويفتح ذراعيه بكل معطياته لأحلام الصغير.
يقول جاك بيرك: "لقد أدرك طه حسين منذ سن مبكرة أنّه محاط بالظلمة، ظلمة باتت تشكل حقيقة وجودية تنطوي على محاربة النهار لليل، والنور للظلام، فمضى يكافح الظلمة أينما وجدت؛ لا ظلمة العمى فحسب، وإنما ذهب يحارب ظلمة الفقر والقهر والجهل".
عندما أسدل الليل ستائره الأبدية، تشكل وعي من نوع آخر لدى الصبي الكفيف، الذي سرعان ما أعاد ترتيب دنياه من جديد، هائماً في ثنايا حكايا الجنيات، وعوالم السحر اللامنظورة؛ حيث يلعب العالم الباطني وشخوصه اللامرئية أدوار البطولة، وكأنّ العقل التائه في الظلام قد آنس أخيراً عالمه المشابه؛ قبل أن يستبدل كل هذا بصوت داخلي كان يؤنس وحدته، ويحفز إرادته باستمرار، مصاحباً إياه على الدرب الطويل من القاهرة إلى باريس، ليبصر من جديد نوراً من نوع آخر، ألا وهو نور المعرفة، الذي وإن دفعه مراراً إلى القلق، لكنّه كان يعود به إلى السكينة والهدوء، فيمضي ينهل منه بلا ارتواء.
بيرك: طه حسين مضى يكافح الظلمة أينما وجدت لا ظلمة العمى فحسب وإنما ظلمة الفقر والقهر والجهل
ربما كان العقل القلق هو أكثر العقول حرصاً على بلوغ المرافئ، رغم إبحاره العاصف في أعتى الأنواء؛ لقد غادر طه حسين شواطئ القياس الرتيبة، ومدارات السرد والتكرار، وسائر المنهجيات الكلاسيكية، ليمضي في تفكيك تراث الأدب العربي، وبالتحديد أحد أبرز مرتكزاته الكبرى، ألا وهو الشعر الجاهلي الذي رسخت منطلقاته في الأذهان لقرون طويلة، وباتت وإن كانت تحمل اسم الجاهلية، كياناً مقدساً بقداسة ما بعده؛ فالتشكيك عند البعض في أحد معطيات لحظة التأسيس، يعني بكل بساطة التشكيك في كل الموروث، وعلى رأسه الديني؛ فالثنائيات المتضادة وحدها تضمن بقاء المنظومة، وبالتالي استمرار سدنة معابد الماضي في ممارسة أدوارهم.
كان شعور طه حسين بالاستغراب فيما يتعلق بذلك التباين بين نصوص الشعر الجاهلي والأوضاع السائدة في عصره، قد دفعه إلى القول في كتابه "في الشعر الجاهلي" إنّ هذا الشعر لا يمثل حالة اللغة العربية في الجاهلية، ولا يمثل الحياة الدينية والعقلية لدى العرب قبل الإسلام، وهو ما يعكس تأثيراً واضحاً للطابع الوضعي لمنهج النقد التاريخي، الذي يفترض أنّ النصوص ينبغي أن تكون مرآة للمجتمعات التي صدرت عنها، وبالتالي يصبح "نقد النص" هو السبيل إلى المعرفة، وما دون ذلك يعد في غمار التاريخ الموازي والحكايا الخرافية.
مضى طه حسين يطبق ما طبقه الأوروبيون على شعر هوميروس، فيما يعرف بالمشكلة الهومرية، ليعرض الوجوه الكثيرة من التشابه بين الشعرين، ويطرح نفس التساؤلات: من نظم الشعر الجاهلي؟ وما هي وسيلة حفظه؛ أكانت الرواية الشفهية أم الكتابة؟ وما هي المدارس اللغوية القديمة التي درست الشعر الجاهلي ونقدته بعد أن جمعته ودوّنته؟ ليخلص في النهاية إلى النتائج التي هزت العقل القياسي الراكد، الذي بات مهدِّداً بانهيار معبد اليقينيات.
ربما كان العقل القلق هو أكثر العقول حرصاً على بلوغ المرافئ رغم إبحاره العاصف في أعتى الأنواء
طرح طه حسين للنقاش إشكالية دراسة الأدب العربي، وكيف أن فقهاءه اكتفوا بجانب واحد فقط؛ فالدارس الحقيقي في نظره يجب أن يتقن اللغات السامية وآدابها، وكذلك اليونانية واللاتينية، وكل المؤثرات التي تداخلت فيما بينها لتنتج هذا التراث الضخم، مثلما فعل الجاحظ الذي تبحّر في علوم الفرس وأتقن فلسفة اليونان وحكمة الهنود، فالأدب لا يمكن أن يظهر بمعزل عن تاريخ المجتمعات التي ينسب إليها، ولا عن ثقافتها وأطرها السوسيولوجية. ثم يطرح السؤال الصادم على شيوخ الأدب العربي: من منكم قرأ الإلياذة والأوديسا؟ من منكم أتقن اليونانية واللاتينية؟ من درس التاريخ بتمعّن وموضوعية؟ ليصل إلى نتيجة حتمية لكل هذا التشرنق حول مفهوم واحد للثقافة، وهي أنّ أنصار الماضي أغلقوا هم الآخرون أبواب الاجتهاد، مثلما فعل علماء الفقه منذ القرن الرابع الهجري، وباتت السكونية هي النمط السائد في الثقافة العربية، التي أخذت تدور في فلك الاستدعاء الدائم للماضي دون تجديد أو ابتكار.
شرع طه حسين في البحث فور أن راودته الشكوك في حقيقة نسبة الأدب الجاهلي، منتهياً إلى أنّ الكثير من هذا اللون الأدبي ليس جاهلياً على الإطلاق، وإنما هي أشعار منحولة بعد ظهور الإسلام؛ لأنها تنتمى لذات البنى اللغوية السائدة، وتعكس حياة المسلمين وطرائقهم وتطلعاتهم وأطرهم السوسيو/ثقافية، فهي في رأيه تنتمى لعالم ما بعد الإسلام أكثر بكثير مما قبله؛ فالشعر المنسوب إلى الأعشى وامرئ القيس وعنترة يكاد ينتمى لنفس المدرسة التي خرج منها شعر الفرزدق وجرير وأبي العتاهية، من حيث البنى اللغوية، والطبيعة الفنية، والروح السائدة.
شكك في حقيقة نسبة الأدب الجاهلي منتهياً إلى أنّ الكثير منه لم يكن جاهلياً على الإطلاق
ثم مضى في كتابه بشكل أكثر جرأة حين تحدث عن شعر أمية بن الصلت، وورود أخبار فيه جاءت في القصص القرآني، مؤكداً أنّ المسلمين نحلوا شعر أمية بن الصلت للتدليل على أنّ ما ورد في القصص القرآني له جذور قديمة في تاريخ جزيرة العرب، وهو فعل بلا قيمة في رأيه ولا يمكن قبول أي مبررات له؛ إذ إنّ نصوص التوراة الأقدم اشتملت على تلك الأخبار التي ترددت فيما بعد في النص القرآني. ثم يمضي مرسياً قواعد المنهج العلمي في معزل عن اليقينيات المطلقة، في رغبة صادقة لمنع الخلط فيقول: "للتوراة أنْ تحدّثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أنْ يحدّثنا عنهما أيضاً، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل إلى مكة".
تفجرت الأزمة بعد نشر الكتاب، وأشعل بعض مشايخ الأزهر الموقف بتنظيم تظاهرات، وتحت الضغط استجابت الحكومة، وسحبت الكتاب، وتناثرت دعوات التكفير تحاصر طه حسين أينما ذهب، وفي 30 أيار (مايو) 1926 تقدم الشيخ خليل حسنين ببلاغ يتهم فيه طه حسين بالطعن في القرآن، وقام الأزهر بتشكيل لجنة لقراءة الكتاب والحكم عليه من الناحية الدينية، ورفعت اللجنة تقريراً إلى شيخ الأزهر جاء فيه: "والكتاب كله مملوء بروح الإلحاد والزندقة، وفيه مغامز عديدة ضد الدين مبثوثة فيه لا يجوز بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن عندهم من المعلومات الدينية ما يتّقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم، والموجب للخلاف والشقاق في الأمة وإثارة فتنة عنيفة دينية ضد دين الدولة ودين الأمة، وترى اللجنة أنّه إذا لم تُكافح هذه الروح الإلحادية ويُقتلع هذا الشر من أصله وتُطهّر دور التعليم من "اللادينية" التي يعمل بعض الأفراد على نشرها بتدبر وإحكام تحت ستار حرية الرأي، اختلّ النظام وفشت الفوضى واضطرب حبل الأمن؛ لأن الدين هو أساس الطمأنينة والنظام، الكتاب وضع في ظاهره لإنكار الشعر الجاهلي، ولكنّ المتأملّ قليلاً يجده دعامة من دعائم الكفر، ومعولاً لهدم الأديان، وكأنّه ما وُضع إلا ليأتي عليها من أصولها وبخاصة الدين الإسلامي، فإنه تذرّع بهذا البحث إلى إنكار أصل كبير من أصول اللغة العربية والشعر والنثر قبل الإسلام مما يُرجع إليه في فهم القرآن والحديث، هذا مما يرمي إليه الكتاب في جملته".
في 30 أيار 1926 تقدم الشيخ خليل حسنين ببلاغ يتهم فيه طه حسين بالطعن في القرآن
هكذا أفصح رجال الكهنوت المتمترسون خلف تراث الماضي حتى وإن كان جاهلياً عن بنى معرفية تيولوجية ضيقة الأفق، فهم لا يطيقون أي حركة في المياه الراكدة، ولا يعرفون للاختلاف أو النقاش العلمي سبيلاً، فكأنّهم يجسدون عن عمد محنة العقل القياسي وجموده.
وعلى الرغم من القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس النيابة بحفظ التحقيق، إلا أنّ الابتزاز لم ينته، واستمر التشهير والضغط على الكاتب بشتى الصور، وباتت القضية أداة مبتذلة للمضاربة السياسية، فبعد سنوات تم استدعاء القضية مرة أخرى عندما رفض طه حسين طلباً من رئيس الوزراء إسماعيل صدقي بكتابة افتتاحية العدد الأول من صحفية الشعب لسان حال الحزب الحاكم، مؤكداً أنه "لا ينبغي لعميد كلية من الكليات أن يسخّر نفسه للكتابة في صحف الحكومة، فيتعرض لازدراء الزملاء والطلاب جميعاً". وعليه، بدأت سلسلة من المضايقات بلغت منحنى خطيراً في آذار (مارس) 1932 حينما أصدر وزير المعارف قراراً بنقل طه حسين، وكان يشغل منصب عميد كلية الآداب آنذاك، إلى وظيفة مراقب التعليم الابتدائي بوزارة المعارف، وهو ما قابله عميد الأدب العربي بالرفض، لتبدأ معركة سياسية كشف فيها طه حسين عن الضغوط التي مارستها عليه الحكومة، وكيف أنّه رفض طلباً بمنح ألقاب شرفية لعدد من السياسيين ممن ينتمون للحزب الحاكم، وعلى الفور ألقت الحكومة بقضية "الشعر الجاهلي" تحت قبة البرلمان، وقدم أحد النواب استجواباً طالب فيه بفصل طه حسين نهائياً، مؤكّداً أنّ "الأمة كانت مخدوعة في هذا الرجل"، بينما قال نائب آخر: "ﻻ يكفينا مطلقاً أن يُنقل طه حسين من الجامعة إلى وزارة المعارف؛ لأن مركزه بالوزارة يمكّنه من الإشراف على فروع تعليم اللغة العربية في أنحاء القطر.. ومثل هذا النقل كمثل نقل جيش اﻻحتلال من العاصمة إلى منطقة القناة، إنّ المعركة الناشبة الآن بين الدين واللادينية، بين الفضيلة والرذيلة، بين الحق والباطل، فلأي فريق تنتصرون؟".
وفي الوقت نفسه اشتعلت الجامعة، وخرجت مظاهرات حاشدة من الطلاب لتأييد طه حسين في محنته، ودفاعاً عن استقلال الجامعة، ودخل طلاب كلية الآداب في إضراب شامل، وسرعان ما انضم إليهم طلاب كليتي الطب والعلوم، وفي 9 آذار (مارس) 1932 استقال رئيس الجامعة أحمد لطفي السيد من منصبه تضامناً مع طه حسين، ليصبح بعد ذلك يوماً لاستقلال الجامعة.
من جهتها قرّرت الحكومة التصعيد؛ حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعاً طارئاً يوم 30 آذار (مارس) 1932 خرج بعده المجلس ببيان مقتضب جاء فيه: "قرر مجلس الوزراء فصل طه حسين أفندي الموظف بوزارة المعارف العمومية من خدمة الحكومة".
عاد طه حسين إلى الجامعة أستاذاً للأدب العام 1934 فعميداً مواصلاً مغامرته الفكرية بين الأنواء
فُصل طه حسين، ومضت الأقلام هنا وهناك تطعن في إيمانه، وتتسابق في مزايدة رخيصة للتشفي منه، فألّف شيخ الأزهر كتاباً بعنوان: "نقض كتاب في الشعر الجاهلي"، لم يخرج فيه عن لغة الخطابة، والمنهج الدائري لتأكيد مروق الكاتب، وكتب الرافعي والغمراوي ومحمد فريد وجدي ومحمد لطفي جمعة وغيرهم في هذا السياق ضمن أكثر من 40 كاتباً ممن ردّوا عليه.
ورغم المحنة، مضى طه حسين ثابتاً، واثقاً من انقشاع ظلمة الجهل ولو بعد حين، فخرج من محنته أصلب عوداً، وأكثر قدرة على النزال، دون أن يقدم أي تنازلات، ومع الضغط وسقوط حكومة إسماعيل صدقي، عاد طه حسين إلى الجامعة أستاذاً للأدب العام 1934، وتولّى العمادة مرة أخرى العام 1936، ليواصل مغامرته الفكرية بين الأنواء، ويصبح العام 1950 وزيراً للمعارف في حكومة الوفد، ويرتقي مكانة لم يكن ليصل إليها لولا ذلك القلق العاصف، وتلك الظلمة التي استفزت كل طاقات النور الكامنة بداخله ومن حوله، وعندها تحقق ما كان مستحيلاً.


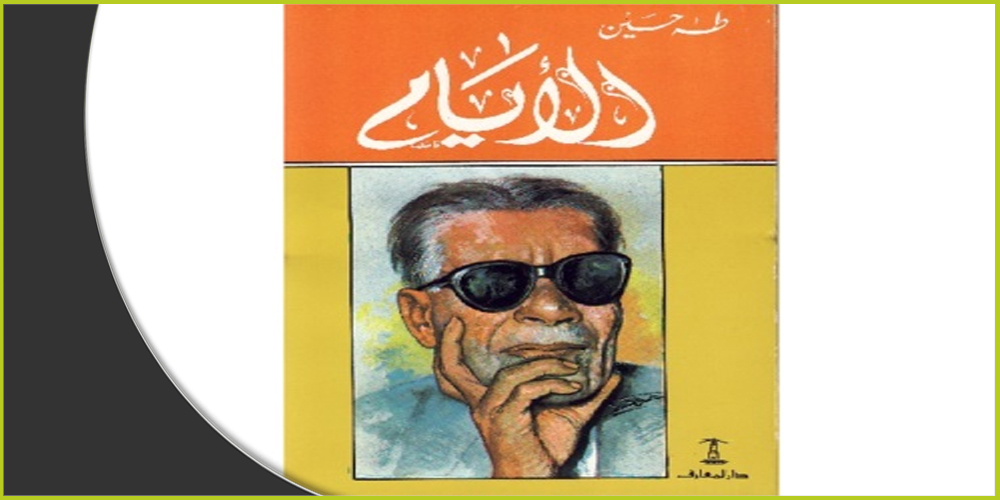
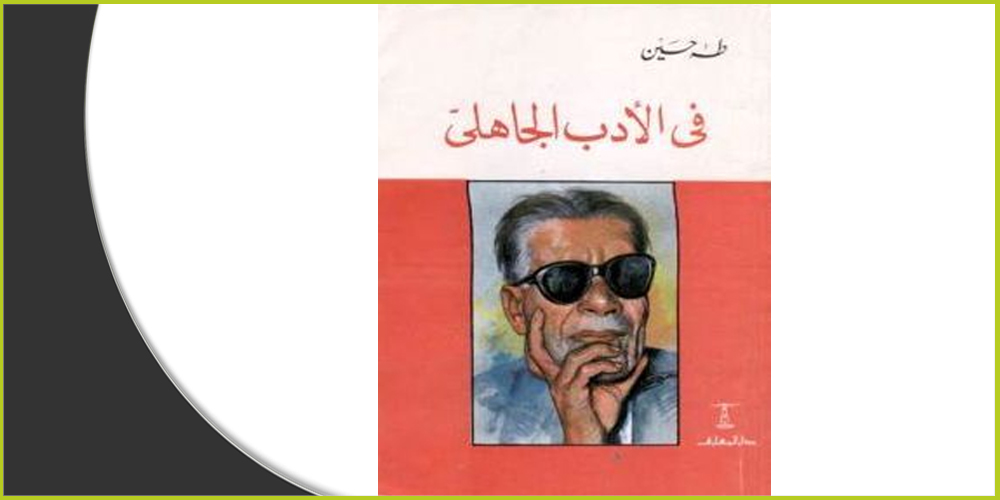

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_15_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=1THGZALq)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_13_0_4_0_0.jpg.webp?itok=HYzwNrak)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/3732f02b-8ed2-4d7f-8254-2fb141b20b28.jpg.webp?itok=pBFiDiVO)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_3_1_2_0.jpg.webp?itok=jMmM_mvk)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/tunis_0.jpg.webp?itok=NUOgyHQe)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B3_0.jpg.webp?itok=8gsmDi4V)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4_111_2_1.jpg.webp?itok=D5F1zEEA)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/00_60.jpg.webp?itok=FIaQFxxe)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%2022_0_1_1_0.png.webp?itok=S-16y1vX)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF_0_0.jpg.webp?itok=SeeHZOLP)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3_34.jpg.webp?itok=sR_3RxiQ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B5_8.jpg.webp?itok=PuVxP5ek)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%861_2_0.png.webp?itok=hdGbwfib)







![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_0_0_1_1_0.jpg.webp?itok=-ojQYLdR)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)

